التقويم التربوي
Résumé de section
-

- اسم المقياس: التقويم التربوي
- وحدة إستكشافية
- السنة: أولى ماستر
- التخصص: علم الاجتماع التربوي
- السداسي: الثاني
- الرصيد: 03
- المعامل : 01
- عدد الساعات: ساعة ونصف أسبوعيًا
- نوع المقياس: نظري
- الأستاذ(ة): حميدة جرو
-

- أن يتعرف الطالب على المفاهيم الأساسية للتقويم التربوي.
- أن يميز بين أنواع وطرق وأدوات التقويم.
- أن يربط بين نظريات التقويم والنظريات السوسيولوجية في تحليل الفعل التربوي.
- أن يطور الطالب القدرة على نقد السياسات التقييمية في المنظومة التربوية من منظور سوسيولوجي.
- أن يوظف أدوات ومؤشرات التقويم في تحليل المناهج والبرامج التعليمية.
-

بنهاية هذا المقياس، يُتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على:
- شرح المفاهيم الأساسية في التقويم التربوي.
- التمييز بين القياس، التقييم، والتقويم.
- تحليل العلاقة بين التقويم والمنظومة التربوية في سياقها الاجتماعي.
- تقديم قراءات نقدية لآليات التقييم في النظم التعليمية.
- تصميم أدوات تقويم تربوي وفق أهداف تعليمية محددة.
-

محاضرة 1: مدخل مفاهيمي حول التقويم التربوي
محاضرة 2: الفروق المفاهيمية بين القياس والتقييم والتقويم التربوي وأدوات
محاضرة 3: أنواع التقويم التربوي
المحاضرة 4: مجالات التقويم التربوي
محاضرة 5: الأخطاء الشائعة في التقويم التربو
محاضرة 6: دور التقويم في تطوير أداء المعلم والمتعل
محاضرة 7: تقويم الأداء في التعليم عن بُعد والتعليم الرقم
محاضرة 8: التقويم التربوي والتنشئة الاجتماعية
محاضرة 9: السياسات التربوية والتقويم في السياق الاجتماعي
المحاضرة 10: التقويم التربوي كمرآة للسياسة التربوية
محاضرة 11: دور البحوث السوسيولوجية في تطوير نماذج تقويمية
-
الخارطة الذهنية لمحاضرات التقويم التربوي لطلبة ماستر1 علم الاجتماع التربية

-


مدخل مفاهيمي حول التقويم التربوي
يُعد التقويم التربوي أحد الركائز الأساسية في العملية التعليمية، إذ يمثل الأداة المنهجية التي تتيح فحص مخرجات التعليم ومدى تحقق الأهداف التربوية، كما يُستخدم لتوجيه قرارات المعلمين والمخططين التربويين وتحسين البرامج التعليمية. فالتقويم ليس مجرد عملية قياس لنتائج المتعلمين، بل هو عملية أعمق تتضمن إصدار أحكام تستند إلى معايير علمية ومعطيات موضوعية بهدف التطوير المستمر. وتبرز أهمية المقاربة السوسيولوجية لفهم أبعاد التقويم، كونه لا يتم بمعزل عن السياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تُؤطر المؤسسة التعليمية.
في بدايته، عرف التقويم باعتباره عملية تهدف إلى التحقق من مدى تحقق الأهداف التعليمية، لكن مع تطور البحوث التربوية توسع المفهوم ليشمل تحليل المعطيات التعليمية وتقديم تغذية راجعة تساعد في تحسين الأداء وتطوير المناهج والبرامج الدراسية. تختلف أنواع التقويم باختلاف التوقيت والوظيفة؛ فهناك التقويم التشخيصي الذي يُستخدم قبل انطلاق العملية التعليمية لفهم قدرات المتعلمين ومدى جاهزيتهم، والتقويم التكويني الذي يُصاحب العملية التعليمية لتصحيح المسار وتقديم الدعم، والتقويم الإجمالي الذي يُستخدم بعد انتهاء التعلم لإصدار حكم نهائي على النتائج، بالإضافة إلى التقويم المستمر الذي يُواكب تطور المتعلم طوال السنة الدراسية.
تتنوع أدوات التقويم التربوي بين الاختبارات بأنواعها، والملاحظة الصفية، والاستبيانات، والمقابلات، وملفات الإنجاز، والعروض التقديمية، والمشاريع الجماعية. وتكمن أهمية تنوع هذه الأدوات في كونها تسمح بتقويم الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للمتعلم، وتُراعي الفروقات الفردية بين المتعلمين.
من منظور سوسيولوجي، يُنظر إلى التقويم التربوي كآلية لها أبعاد رمزية واجتماعية. فبحسب علماء الاجتماع التربوي، لا يمكن فصل التقويم عن بنيات السلطة والمعايير الثقافية السائدة في المجتمع. وقد أشار "بيير بورديو" إلى أنّ التقويم قد يُستخدم كأداة لإعادة إنتاج الفوارق الطبقية من خلال فرض معايير ثقافية معينة على جميع المتعلمين دون مراعاة خلفياتهم الاجتماعية والثقافية، ما يؤدي إلى تهميش البعض وتعزيز نجاح فئات أخرى. ومن هذا المنظور، فإن التقويم ليس محايدًا كما قد يبدو، بل قد يكون وسيلة للفرز الاجتماعي والتمييز الرمزي داخل المدرسة.
كما أن أنظمة التقويم تختلف من مجتمع لآخر، وتعكس في جوهرها الفلسفة التربوية السائدة. فبينما تعتمد بعض الدول كفنلندا على نماذج تقويمية تشاركية وبنائية تُشجع التفكير النقدي والتعلم الذاتي، لا تزال أنظمة تعليمية أخرى، منها الجزائر، تركّز على الامتحانات الموحدة والتقويم الإجمالي، ما يُقيد فرص الابتكار ويُقلل من فعالية التقويم التكويني والبديل.
ومن هنا، أصبح من الضروري إعادة النظر في وظائف التقويم من حيث كونه ليس مجرد وسيلة للحكم على المتعلم، بل أداة للتوجيه والتحفيز والبناء. فالتقويم العادل ينبغي أن يكون تشاركيًا، يدمج المتعلم في عملية التقييم ويشجعه على تقييم ذاته وتطويرها. كما يجب أن يكون التقويم شموليًا، يأخذ في الحسبان مختلف أبعاد شخصية المتعلم، ويستخدم أدوات متنوعة تراعي الذكاءات المتعددة والأنماط المختلفة للتعلم.
في الختام، يمكن القول إنّ التقويم التربوي في ضوء المنظور السوسيولوجي لا يجب أن يُفهم فقط كآلية تعليمية، بل كظاهرة اجتماعية تعكس بنية المجتمع ومفاهيمه عن الجدارة والنجاح. وبالتالي، فإن تطوير منظومة التقويم يتطلب وعيًا نقديًا بأبعاده الثقافية والسياسية، وسعيًا جادًا نحو تقويم عادل، تشاركي، وهادف، يعزز من جودة التعليم ويسهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي داخل المدرسة وخارجها.
-
موجهة لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
موجهة لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
-


المحاضرة حول أنواع التقويم التربوي
يُعد التقويم التربوي عنصرًا أساسيًا في منظومة التعليم، لا يمكن الاستغناء عنه أو اختزاله في مجرد اختبارات أو امتحانات، بل هو عملية مستمرة وشاملة تهدف إلى دعم وتحسين التعلم في جميع مراحله. فالتقويم يسعى إلى تتبع تطور المتعلم، والكشف عن نقاط القوة والضعف، وتقديم تغذية راجعة فعّالة تساعده على تعديل مساره، إلى جانب كونه أداة يستخدمها المعلمون وصناع القرار لتطوير السياسات التعليمية. وهنا يجب التمييز بين القياس، الذي يعبر عن الكم من خلال الدرجات أو الأرقام؛ والتقدير، الذي يُعنى بالحكم النوعي أو الوصفي؛ وبين التقويم، الذي يدمج بين الاثنين معًا، ويُسخّرهما لاتخاذ قرارات تربوية هادفة. كما أن للتقويم التربوي أنواعًا مختلفة تخدم أهدافًا متعددة، منها: التقويم التشخيصي الذي يُستخدم قبل بداية التعليم لتحديد المستوى القبلي للمتعلمين، والتقويم التكويني الذي يصاحب مراحل التعلم ويوجهها، والتقويم الختامي أو الإجمالي الذي يُستخدم في نهاية مرحلة تعليمية لتحديد مدى تحقق الأهداف، والتقويم المستمر الذي يتابع الأداء التعليمي طوال العام. كما برزت حديثًا أشكال أخرى مثل التقويم الذاتي وتقويم الأقران، والتي تهدف إلى تنمية مهارات النقد الذاتي والتفكير التأملي لدى المتعلم. ويمثل هذا التنوع في أدوات وأنواع التقويم دليلاً على تطور الفكر التربوي، وتحول نظرة التربية من الحفظ والاستظهار إلى الفهم والتحليل. ومن هنا، فإن اعتماد تقويم تربوي شامل يراعي الفروقات الفردية، ويبتعد عن الاقتصار على الامتحانات النهائية، يسهم في تحقيق العدالة التعليمية ويضمن جودة مخرجات التعليم، ويعزز من دور المدرسة كمؤسسة لبناء الفرد والمجتمع.
-
موجهة لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
محاضرة موجهة لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
محاضرة لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
-


محاضرة: الفروق المفاهيمية بين القياس والتقييم والتقويم التربوي وأدواته
في إطار العملية التربوية، تظهر ثلاثة مفاهيم مركزية ترتبط بجودة التعليم ومخرجاته، وهي: القياس التربوي، التقييم التربوي، والتقويم التربوي. يُقصد بالقياس التربوي تلك العملية الكمية التي تعتمد على أدوات رقمية لقياس قدرات المتعلم أو تحصيله المعرفي، مثل الدرجات والعلامات، دون الخوض في تفسير هذه النتائج أو توجيه قرارات تربوية بناءً عليها. أما التقييم التربوي، فهو أوسع من القياس، إذ يتضمن إصدار حكم على الأداء أو المحتوى أو البرنامج التعليمي، ويركّز على تقدير مدى تحقيق الأهداف التعليمية وجودة العملية التربوية. بينما يُعد التقويم التربوي المفهوم الأوسع والأشمل، حيث يجمع بين القياس والتقييم، ويُضاف إليهما هدف أساسي هو التحسين والتعديل واتخاذ قرارات تربوية مدروسة بناءً على نتائج القياس والتقييم، مما يجعل منه عملية مستمرة ترافق كل مراحل التعليم. ويُفرّق بعض الباحثين بين التقييم والتقويم بكون الأول يركز على الحكم، بينما الثاني يربط بين التشخيص والمعالجة. ولإنجاز هذه العمليات، يعتمد التربويون على عدة أدوات، منها: الاختبارات التحصيلية (الموضوعية والمقالية)، الملاحظة، المقابلات، قوائم التقدير، سلالم التقدير، ملفات الإنجاز، والاستبيانات، حيث تُستخدم كل أداة بحسب طبيعة الهدف التعليمي والمجال المُراد تقويمه سواء كان معرفيًا، مهاريًا أو وجدانيًا. إن فهم هذه الفروقات المفاهيمية وأدوات التقويم يُعد ضرورة لكل فاعل تربوي يسعى لتحسين الأداء التربوي وضمان تحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة وعدالة.
-
محاضرات لطلبة ماستر1 علم الاجتماع التربية
-
رابط فيديو المحاضرة لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
-
محاضرة: مجالات التقويم التربوي


يُعد التقويم التربوي عنصرًا محوريًا في المنظومة التعليمية، كونه يمثل الوسيلة التي من خلالها يتم تحديد مدى نجاح العملية التعليمية في تحقيق أهدافها، كما أنه أداة لاتخاذ القرارات التربوية المناسبة، سواء على مستوى المتعلم أو المعلم أو المؤسسة التعليمية ككل. والتقويم ليس ممارسة حيادية أو تقنية بحتة، بل هو انعكاس لتصورات فلسفية وتربوية واجتماعية. ولهذا، فإن دراسته ضمن تخصص علم اجتماع التربية تتيح لنا فهمه كأداة لإنتاج المعنى، وإعادة تنظيم الواقع المدرسي والاجتماعي.
يُصنف التقويم التربوي إلى أنواع متعددة، كل منها يؤدي وظيفة معينة في سياق العملية التعليمية. أول هذه الأنواع هو التقويم التشخيصي، ويُستخدم عادةً في بداية العملية التعليمية، حيث يهدف إلى الكشف عن خلفية المتعلم المعرفية، ورصد نقاط القوة والضعف لديه، وتحديد الحاجات التعليمية الفردية، مما يساعد المعلم على تخطيط التدريس بشكل يتناسب مع الفروق الفردية بين الطلبة. أما النوع الثاني فهو التقويم التكويني (أو البنائي)، ويُمارس خلال سيرورة التعلم، إذ يُستخدم كأداة لتغذية راجعة مستمرة تساعد المتعلم على تحسين أدائه، كما تمكّن المعلم من تعديل استراتيجياته التعليمية. التقويم التكويني يعزز مشاركة المتعلم في بناء تعلمه الذاتي، ويؤدي دورًا مهمًا في الحد من الفشل الدراسي إذا ما تم تفعيله بفعالية.
أما النوع الثالث، فهو التقويم الإجمالي (أو الختامي)، ويتم عادةً في نهاية فترة تعليمية معينة، كالفصل الدراسي أو الوحدة التعليمية، وهو يهدف إلى إصدار حكم نهائي على مدى تحقق الأهداف التعليمية. غالبًا ما يُستخدم هذا النوع من التقويم في القرارات المصيرية، كترفيع التلميذ أو منحه شهادة أو تقويم البرامج. غير أن التقويم الإجمالي كثيرًا ما يُنتقد لكونه يعتمد بشكل كبير على الاختبارات الكمية، ويغفل الأبعاد الشخصية والاجتماعية والمعرفية المتكاملة للمتعلم. وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى أنماط تقويم أكثر شمولية، تأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والثقافي والتربوي.
ومن أنواع التقويم كذلك، التقويم الذاتي، حيث يقوم المتعلم أو المعلم بتقويم أدائه بنفسه، ما يعزز المسؤولية والوعي الذاتي. وهناك أيضًا التقويم التشاركي، الذي يدمج أطرافًا متعددة كالمتعلم، المعلم، أولياء الأمور، والمجتمع المحلي، مما يجعله أداة فعالة في تعزيز الديمقراطية التربوية.
وبالإضافة إلى أنواع التقويم، فإن للتقويم مجالات متعددة تغطي مختلف جوانب النظام التربوي. أول هذه المجالات هو تقويم المتعلم، وهو المجال الأكثر شيوعًا في الأوساط التعليمية، حيث يهدف إلى قياس المعرفة والمهارات والكفايات التي اكتسبها المتعلم. إلا أن هذا النوع من التقويم لا ينبغي أن يقتصر على الاختبارات الكتابية، بل يجب أن يشمل تقويم القدرات التواصلية والاجتماعية والوجدانية، خاصة إذا كنا نتبنى مقاربة سوسيولوجية تأخذ في الاعتبار الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمتعلم.
مجال آخر مهم هو تقويم المعلم، والذي لا يعني فقط تقويم معرفته الأكاديمية، بل يشمل أسلوبه في التدريس، قدرته على التواصل، حسه التربوي، مهاراته في إدارة الصف، ومدى مراعاته للبعد الإنساني والاجتماعي في تعامله مع المتعلمين. وفي هذا الإطار، لا بد من اعتبار أن أداء المعلم يتأثر بدوره بالظروف المؤسسية والسياسات التعليمية، وبالتالي فإن تقويمه ينبغي أن يتم في إطار نظرة شمولية.
من المجالات المهمة أيضًا تقويم المناهج الدراسية، ويشمل تحليل مدى ملاءمتها لحاجات المتعلمين والمجتمع، مدى ارتباطها بسوق العمل، وإدماجها للثقافة المحلية والقيم الوطنية. كما يُعد تقويم المؤسسة التعليمية مجالاً لا غنى عنه، ويتعلق بدراسة أداء المدرسة كوحدة تنظيمية: البنية التحتية، المناخ المدرسي، طرق التسيير، الدعم النفسي والاجتماعي، ونوعية العلاقات داخل المؤسسة.
وفي العصر الرقمي، أصبح من الضروري الحديث عن تقويم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وهو مجال حديث يتطلب أدوات جديدة قادرة على تقويم التعلم في بيئة افتراضية، مع مراعاة الفوارق الرقمية والاجتماعية بين المتعلمين. كما برز كذلك تقويم السياسات التعليمية كمجال استراتيجي يربط بين المخرجات التعليمية والأهداف التنموية للمجتمع، ويتطلب مؤشرات كمية ونوعية لرصد العدالة التربوية، الإنصاف، والمردودية الداخلية والخارجية للنظام التربوي.
تُظهر لنا هذه الأنواع والمجالات أن التقويم التربوي ليس مجرد إجراء تقني، بل هو عملية معقدة تتداخل فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والسياسية. ولهذا، فإن علم اجتماع التربية مدعو إلى تقديم قراءات نقدية للتقويم، تكشف عن أبعاده الرمزية والثقافية، وتسعى إلى تطوير نماذج أكثر شمولية وإنصافًا، خاصة في ظل تفاقم الفجوات الاجتماعية والمعرفية بين المتعلمين.
-
رابط فيديو المحاضرة لطلبة ماستر1 علم الاجتماع التربية
-


يُعدّ التقويم التربوي عملية محورية في النظام التعليمي، فهو لا يقتصر على قياس تحصيل المتعلمين فحسب، بل يُستخدم لتشخيص صعوباتهم، وتوجيه العملية التعليمية، وضمان تحقيق الأهداف التربوية بكفاءة وفعالية. غير أن هذه العملية، التي يفترض أن تتسم بالموضوعية والعدالة، قد تتأثر بجملة من الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تشويه نتائج التقويم وفقدان مصداقيته. ومن هنا، فإنّ الوقوف على هذه الأخطاء وتحليلها يعد أمرًا ضروريًا لكل من يهتم بالشأن التربوي.
تتعدد الأخطاء الشائعة في التقويم التربوي، ويمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية: أخطاء ناتجة عن سلوك المعلم، وأخطاء في أدوات التقويم، وأخطاء إجرائية، وأخطاء في التصحيح وإعطاء العلامات. فمن جهة المعلم، نجد أخطاء مثل التحيّز الشخصي نحو بعض الطلبة، وخطأ الهالة الذي يجعل المقوِّم يمنح علامة عالية لطالب متفوق في مادة أخرى دون أن يتحقق من إجاباته، بالإضافة إلى التشدد أو التساهل غير المبرر في التصحيح، والمقارنة بين الطلبة بدلًا من اعتماد معايير محددة. أما من حيث أدوات التقويم، فقد تتجلى الأخطاء في صياغة أسئلة غير واضحة، أو التركيز على جانب واحد من جوانب التعلم مثل الحفظ فقط، أو تجاهل الفروقات الفردية في مستوى الطلبة.
كما تظهر أخطاء أخرى تتعلق بتنظيم وإجراء عملية التقويم، مثل توقيت غير مناسب للاختبار، أو عدم توفير بيئة مناسبة للتركيز، أو إعطاء تعليمات غامضة تربك المتعلمين. وتُستكمل هذه السلسلة بأخطاء في عملية التصحيح، كغياب سلم واضح للتنقيط، والتناقض في منح العلامات، وتغليب الشكل على المضمون عند تقييم الإجابات. تؤدي هذه الأخطاء مجتمعة إلى نتائج غير دقيقة حول مستوى الطالب الحقيقي، مما ينعكس سلبًا على مساره الدراسي، ويُفقده الثقة بالنفس، ويُضعف العلاقة بينه وبين المؤسسة التربوية، وقد يؤدي إلى قرارات تعليمية غير عادلة كالإعادة أو الرسوب أو التوجيه الخاطئ.
وللحد من هذه الأخطاء، ينبغي تبني مجموعة من الإجراءات التصحيحية، في مقدمتها تكوين المعلمين وتدريبهم على مهارات إعداد أدوات التقويم، والتصحيح الموضوعي، وتجنب التحيزات الشخصية. كما يجب أن يكون التقويم متنوعًا يشمل اختبارات تحريرية وشفوية، وملاحظات صفية، ومهام تطبيقية، مع مراعاة الأهداف التعليمية والفروقات الفردية بين المتعلمين. إضافة إلى ذلك، فإن توفير بيئة ملائمة أثناء التقويم، وتوضيح التعليمات، واعتماد آليات مراجعة جماعية للتصحيح، كلها خطوات مهمة لتعزيز دقة وعدالة التقويم
في هذا السياق، يصبح التقويم التربوي أداة فعالة لتحسين جودة التعليم متى ما تم بناؤه وتطبيقه بشكل علمي ومدروس، بعيدًا عن الانطباعات الشخصية أو الممارسات العشوائية. فهو ليس مجرد وسيلة للحكم على الطالب بالنجاح أو الرسوب، بل عملية تربوية شاملة تهدف إلى دعم التعلم، وتوجيه المعلمين، وتطوير المناهج. إنّ وعي المعلم بالأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها، وقدرته على تجنبها، يعكس نضجه المهني والتربوي، ويساهم في ترسيخ العدالة التربوية داخل القسم، كما يُعزز من مصداقية المؤسسة التعليمية أمام الطالب والمجتمع.
وختامًا، فإنّ تقويمًا سليمًا وعادلًا هو ذاك الذي يُراعي تنوع قدرات المتعلمين، ويتسم بالوضوح، والموضوعية، والتدرج المنهجي، ويُسهم في بناء بيئة تعليمية محفّزة ومشجعة على التعلم. لذا يجب أن يُنظر إلى الأخطاء الشائعة في التقويم التربوي لا كعقبات حتمية، بل كفرص للتطوير المهني والتربوي المستمر، من خلال مراجعة الممارسات، والانفتاح على أساليب جديدة في التقييم، والاستفادة من البحوث التربوية في هذا المجال.
-


يُعد التقويم التربوي عنصرًا جوهريًا ومحوريًا في المنظومة التعليمية، إذ لا يقتصر دوره على تحديد مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين، بل يتجاوزه ليكون أداة فعالة لتحسين جودة التعليم وتطوير الأداء التربوي بصفة عامة. فالتقويم، في جوهره، هو عملية منظمة تهدف إلى جمع معلومات دقيقة وموضوعية حول أداء المعلم والمتعلم، وتحليلها من أجل إصدار أحكام تساعد على اتخاذ قرارات تربوية صائبة. فالمعلم الذي يعتمد على نتائج التقويم يستطيع مراجعة خططه التدريسية، وتحسين طرائق تدريسه، واختيار الأنشطة والوسائل المناسبة التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. كما أن هذه النتائج تتيح له اكتشاف مدى تحقق الأهداف التعليمية، وتقييم تفاعل المتعلمين مع المحتوى الدراسي، مما يدفعه إلى التجديد المستمر في أساليبه، والبحث عن استراتيجيات أكثر فاعلية. ولا يقل دور التقويم أهمية بالنسبة للمتعلم، حيث يسمح له بالتعرف على مستواه الفعلي في التحصيل، ويُوجهه نحو ما يحتاج إلى تعزيزه أو تحسينه. وعندما يتم توظيف التقويم بطريقة بنائية، يصبح المتعلم أكثر وعيًا بمواطن قوته وضعفه، مما يُنمي لديه مهارات التنظيم الذاتي، والتخطيط، واتخاذ القرار، ويحفزه على التعلم النشط والمستمر، بعيدًا عن التلقين والحفظ الآلي.
إن التقويم الحديث لا ينبغي أن يُفهم كمجرد اختبار نهائي للحكم على النجاح أو الفشل، بل كعملية مستمرة ومتدرجة تبدأ منذ بداية العملية التعليمية وترافقها في كل مراحلها، ويُطلق على هذا النوع بالتقويم التكويني أو البنائي، وهو يهدف إلى التحسين المستمر، سواء على مستوى الأداء الفردي أو الجماعي. ويتطلب هذا النوع من التقويم مشاركة فاعلة من المتعلمين، وتوظيف أدوات متنوعة مثل المشاريع، العروض، العمل الجماعي، التقييم الذاتي وتقييم الأقران، وهي أدوات تُعزز من دور المتعلم كمشارك نشط في بناء معرفته. أما بالنسبة للمعلم، فإن التقويم يوفر له تغذية راجعة تساعده على تحسين أدائه المهني، وتمكنه من ممارسة عملية تعليمية قائمة على الأدلة، وليس على الانطباعات الشخصية أو العشوائية. كما أن المؤسسات التعليمية التي توظف التقويم بشكل استراتيجي تستطيع متابعة أداء المعلمين بشكل منهجي، وتحديد احتياجاتهم التكوينية، وتوفير برامج تدريب مهني قائمة على نتائج واقعية.
ورغم هذه الأهمية، إلا أن التقويم يواجه تحديات ومعوقات متعددة، منها هيمنة النمط التقليدي الذي يركّز على الاختبارات الكتابية الموحدة، وإهمال الجوانب الوجدانية والمهارية في عملية التقييم، بالإضافة إلى ضعف تكوين بعض المعلمين في مجال تصميم أدوات تقويم فعالة وشاملة. كما أن نقص الإمكانات والتجهيزات التكنولوجية في بعض البيئات التعليمية يحد من فاعلية أساليب التقويم الرقمية أو التفاعلية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في فلسفة التقويم، وتطوير السياسات التربوية التي تنظّمه، وتوفير برامج تدريب متخصصة للمعلمين في هذا المجال، إضافة إلى خلق ثقافة مدرسية تشجع على ممارسة التقويم كعملية تعلم مستمرة وليست فقط أداة للقياس.
وباختصار، يمكن القول إن التقويم يُعد دعامة أساسية لتجويد التعليم وتحقيق التنمية المهنية للمعلمين والتحصيل الفعال للمتعلمين. فهو يشكل جسرًا حيويًا بين الفعل التعليمي ونتائجه، وبين ما يُخطط له من أهداف وما يتحقق منها في الواقع. وكلما كانت عملية التقويم قائمة على أسس علمية واضحة، ومستندة إلى معايير دقيقة ومتكاملة، كلما كان أثرها أعمق في تطوير الأداء ورفع جودة التعليم. لذلك، فإن استثمار الجهود في تحسين ممارسات التقويم، وتبني نظرة شاملة ومتكاملة له، يشكل خطوة أساسية نحو بناء مدرسة حديثة ترتكز على الكفاءة والجودة والمساءلة والتطوير المستدام.
-
لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
-


يُعد تقويم الأداء في التعليم عن بُعد والتعليم الرقمي من التحديات الحديثة التي فرضتها التحولات التكنولوجية المتسارعة في مجال التعليم. ففي ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، لم يعد التقويم يقتصر على الأساليب التقليدية المرتبطة بالتعليم الحضوري، بل أصبح من الضروري تطوير آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البيئة الرقمية، وأنماط التفاعل بين الطالب والمعلّم، وكذلك خصوصية المحتوى الرقمي. هذا ما يفرض إعادة النظر في مفاهيم الجودة، ومعايير التقييم، وأدوات جمع البيانات الخاصة بأداء المتعلم في هذا السياق الجديد.
يختلف تقويم الأداء في التعليم عن بعد عن نظيره في التعليم التقليدي من حيث المنهجية والأدوات والمعايير. ففي حين يرتكز التعليم الحضوري على الملاحظة المباشرة والمشاركة الصفية، يعتمد التعليم الرقمي على التفاعل غير المباشر، وتسجيل البيانات، واستخدام البرمجيات التي تتابع تقدم الطلبة بشكل آلي. لذا، فإن أدوات التقويم أصبحت متنوعة، وتشمل الواجبات الإلكترونية، الاختبارات عبر الإنترنت، التقييم الذاتي، تقويم الأقران، والأنشطة التفاعلية مثل المنتديات والمشاريع الجماعية الرقمية. هذا التنوع يُمكّن الأستاذ من جمع معلومات أعمق عن مدى استيعاب الطالب، لكنه يتطلب كذلك كفاءة رقمية عالية.
من جهة أخرى، يواجه تقويم الأداء الرقمي عددًا من التحديات، أبرزها ضعف المصداقية الأكاديمية في بعض الحالات، وصعوبة التحقق من هوية الطالب أثناء الاختبارات، بالإضافة إلى الفجوة الرقمية بين الطلبة من حيث الإمكانيات والمهارات. كما أن غياب التفاعل الوجاهي قد يؤثر سلبًا على دقة الحكم على أداء الطالب، خاصة في الجوانب المتعلقة بالاتصال الشفهي، والسلوك التعاوني، والمشاركة الفعلية. لذلك، يُطرح سؤال جوهري حول مدى عدالة وموضوعية التقويم في هذا السياق، وما إذا كانت المعايير المستخدمة تراعي الفروق الفردية والبيئية بين المتعلمين.
في المقابل، تتيح البيئة الرقمية إمكانيات واسعة لتحسين جودة التقويم، إذا ما تم استغلالها بشكل سليم. إذ يمكن عبر التحليلات الرقمية (Learning Analytics) تتبع تقدم كل طالب بشكل مفصّل، ومعرفة نقاط الضعف والقوة لديه، وتوفير تغذية راجعة فورية، مما يُعزز من فاعلية التعلم الذاتي. كما تُمكّن أدوات التقييم المستمر من مراقبة الأداء بشكل دوري، وليس فقط عبر اختبار نهائي، وهو ما يتماشى مع فلسفة التقويم التكويني. وتعد المرونة في الوقت والمكان أحد أبرز مزايا التقويم الرقمي، حيث يستطيع الطالب أداء المهام متى يشاء، ما يخفف من الضغط النفسي
تتطلب فعالية تقويم الأداء في التعليم الرقمي توفر مجموعة من الشروط الأساسية، منها وضوح الأهداف التعليمية، وتنوع أساليب التقويم بما يناسب المهارات والمعارف المطلوبة، واعتماد معايير تقييم دقيقة وشفافة يمكن مشاركتها مع الطلبة منذ بداية المسار التعليمي. كما ينبغي أن يُرفق التقويم بتغذية راجعة فورية وموجهة، تساعد الطالب على تصحيح أخطائه وتحسين مستواه بشكل مستمر. ومن الضروري كذلك أن يتم تدريب الأساتذة على استخدام أدوات التقويم الرقمي وتطوير كفاءاتهم في تصميم الأنشطة التفاعلية ومتابعة الأداء إلكترونيًا.
إن العلاقة بين التعليم الرقمي والتقويم علاقة تكاملية؛ فكما أن التعليم الرقمي يغير طبيعة التعلم، فإن التقويم الرقمي يعيد تعريف مفهوم "الأداء" ذاته، إذ لم يعد الأداء محصورًا في الامتحان الكتابي، بل يشمل إنتاج الوسائط الرقمية، والمشاركة في المنتديات التعليمية، وتقديم المشاريع المشتركة، وحل المشكلات بطريقة إبداعية. كل هذه المؤشرات تشكل معًا صورة شاملة لأداء الطالب في البيئة الرقمية، وتحتاج إلى تقويم شامل يجمع بين الكمي والنوعي، وبين الآلي والبشري، وبين الفردي والجماعي.
في ضوء ما سبق، يمكن القول إن تقويم الأداء في التعليم عن بُعد والتعليم الرقمي يشكّل خطوة أساسية نحو بناء منظومة تعليمية أكثر عدالة ومرونة وكفاءة، بشرط أن يتم توجيهه وفق فلسفة تربوية واضحة، تضع المتعلم في قلب العملية، وتستخدم التكنولوجيا كوسيلة وليس كغاية. كما يتطلب ذلك وضع سياسات تربوية جديدة تُنظّم التقويم الرقمي، وتضمن مصداقيته، وتحفّز الابتكار فيه، بدلًا من نسخه من النماذج التقليدية.
وأخيرًا، فإن نجاح تقويم الأداء في البيئة الرقمية لا يتحقق فقط بالأدوات والمنصات، بل بوجود رؤية تربوية شاملة، تدمج بين العنصر البشري والتقني، وتراعي العدالة التربوية، وتُشرك الطالب في تقويم ذاته، وتُحفّزه على التعلم المستمر. ومن هنا، فإن تطوير التقويم الرقمي يجب أن يكون من أولويات مؤسسات التعليم العالي، خاصة في التخصصات المرتبطة بسوسيولوجيا التربية، لأن جودة التقويم تعني بالضرورة جودة المخرجات التعليمية.
-
لطلبة الماستر 1 علم الاجتماع التربية
-


تتناول هذه المحاضرة العلاقة العميقة والمتداخلة بين التقويم التربوي والتنشئة الاجتماعية، باعتبار أن العملية التربوية لا تقتصر فقط على نقل المعارف والمهارات، بل تتعداها لتشمل بناء الشخصية وإكساب الفرد القيم والمعايير الاجتماعية. ويُعد التقويم التربوي أداة مركزية في هذا السياق، حيث لا يُستخدم فقط لقياس التحصيل الدراسي، بل يتجاوز ذلك ليؤدي دورًا في عملية الضبط الاجتماعي والتأثير في اتجاهات وسلوكيات المتعلمين. فكل قرار تقويمي – سواء كان امتحانًا، ملاحظة مستمرة، أو تقييمًا شاملًا – يحمل في طياته رسالة اجتماعية تُوجّه المتعلم نحو ما يُعتبر مقبولًا أو مرفوضًا في البيئة المدرسية والمجتمع ككل. كما أن أساليب التقويم، إذا كانت عادلة وشاملة وتراعي الفروق الفردية، فإنها تُعزز الإحساس بالمساواة والانتماء، وتُسهم في بناء الثقة والمسؤولية لدى التلميذ، أما إذا كانت تقليدية أو إقصائية، فقد تؤدي إلى تعزيز الإحباط والتهميش وتكريس الفوارق الاجتماعية والثقافية. من هنا، فإن التنشئة الاجتماعية لا تتم فقط عبر المنهج والمحتوى، بل أيضًا عبر ما يسمى بـ"المنهج الخفي" الذي يظهر من خلال طرق التقويم، والتفاعلات الصفية، وآليات المكافأة والعقاب. فالتقويم في بعده السوسيولوجي يُسهم في نقل الثقافة الاجتماعية وإعادة إنتاجها، ويساعد في ترسيخ الأدوار الاجتماعية المستقبلية للأفراد. وتُعد المدرسة، بهذا المعنى، فضاءً اجتماعيًا يعيد تشكيل الأفراد وفقًا لمتطلبات النظام الاجتماعي، حيث يكون التقويم أحد أدوات هذه العملية. وتؤكد النظريات السوسيولوجية الحديثة – كنظرية بورديو في "العنف الرمزي" – أن التقويم قد يحمل معايير طبقية وثقافية مضمَنة يتم تمريرها تحت غطاء الحيادية والموضوعية. ولذلك، تطرح هذه المحاضرة تساؤلات حول ضرورة تطوير أدوات تقويمية تراعي البُعد الاجتماعي والثقافي، وتُسهم في دمج كافة المتعلمين، وتحقيق أهداف التنشئة الاجتماعية العادلة، ما يجعل من التقويم التربوي وسيلة إصلاحية تربط بين التعليم والتنمية الاجتماعية المستدامة.
-
محاضرة موجهة لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
مةجفة لطلبة ماستر1 علم الاجتماع التربية
-
-


المحاضرة: السياسات التربوية والتقويم في السياق الاجتماعي
اهداف المحاضرة:
فهم العلاقة بين السياسات التربوية والسياق الاجتماعي.
• تحليل دور السياسات التربوية في تكوين وتوجيه المنظومة التعليمية.
• دراسة آليات التقويم كأداة للضبط والتحسين داخل النظام التربوي.
• تقييم تأثير البنية الاجتماعية في صياغة وتنفيذ السياسات التربوية.
المحاضرة تبحث في التفاعل المعقد بين السياسات التربوية والتقويم التربوي داخل الإطار الاجتماعي، حيث تُعد السياسة التربوية انعكاسًا لتوجهات المجتمع ومصالحه الطبقية والثقافية، وتُصاغ في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، ما يجعل التعليم أحيانًا وسيلة للتحرر، وأحيانًا أخرى أداة لإعادة إنتاج البُنى الاجتماعية القائمة. فهذه السياسات لا تُبنى بمعزل عن السياق، بل تعكس تصورات مجتمعية حول المعرفة، المواطنة، والعدالة، وهو ما يجعل من المناهج والبرامج التعليمية ميدانًا للصراع الأيديولوجي والثقافي. وفي المقابل، يلعب التقويم دورًا مركزيًا ليس فقط في قياس أداء المتعلمين، بل في تحديد مصيرهم داخل النظام الاجتماعي، إذ غالبًا ما يحمل في طياته رموزًا ومعايير تنحاز ضمنيًا إلى فئات دون أخرى، مما يُكرّس الفوارق بدل أن يُقلّصها، كما أشار بيير بورديو من خلال مفهوم "العنف الرمزي". ومن خلال تحليل بعض التجارب، كحالة الجزائر التي شهدت عدة إصلاحات لم تخرج بعد من إشكالات الفجوة بين التخطيط والتطبيق، مقابل نموذج فنلندا الذي يكرس المساواة التعليمية، يتضح أن السياسات التربوية الناجحة هي تلك التي تنطلق من الواقع الاجتماعي وتراعي التنوع الثقافي وتعمل على إرساء الإنصاف التربوي، لا فقط من خلال توزيع الموارد، بل أيضًا من خلال بناء تقويمات عادلة ومرنة. ومن هنا تبرز أهمية المقاربة السوسيولوجية في فهم السياسات التربوية ليس فقط كنصوص وقرارات، بل كآليات اجتماعية تعيد تشكيل المجتمع وتؤثر في فرص الأفراد ومستقبلهم.
-
موجهة لطلبة ماستر علم اجتماع التربية
-
موجهة لطلبة ماستر علم اجتماع التربية
-
عرض موجهة لطلبة ماستر علم اجتماع التربية
-
موجهة لطلبة ماستر علم اجتماع التربية
-
-


محاضرة: التقويم التربوي كمرآة للسياسة التربوية
يُعد التقويم التربوي من أهم المكونات الحيوية في النظام التعليمي، لما له من دور محوري في قياس فاعلية العملية التربوية بجميع عناصرها. إلا أن دوره لا يتوقف عند مجرد جمع البيانات أو إصدار الأحكام بشأن أداء التلاميذ أو المعلمين، بل يتجاوز ذلك ليصبح أداة استراتيجية تسهم في بناء، توجيه، وتقويم السياسة التربوية نفسها. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار التقويم التربوي مرآة تعكس بوضوح طبيعة السياسة التعليمية المتبعة، ومدى واقعيتها ونجاعتها في تجسيد الأهداف التي تسطرها الدولة في ميدان التربية والتكوين.
إن السياسة التربوية لأي دولة هي تجلٍّ للرؤية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تتبناها، وهي تسعى من خلالها إلى إعداد المواطن الذي يتماشى مع نموذج التنمية المنشودة. لذلك، فإن آليات التقويم التربوي، بأدواتها ومقاييسها، لا تُبنى بشكل اعتباطي أو محايد، بل تعكس ما تعتبره الدولة مهمًا في شخصية المتعلم وفي مخرجات التعليم. فإذا كانت السياسة التربوية تركّز على تنمية القدرات الإبداعية، فإن التقويم سيتّجه إلى قياس مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. أما إذا كانت السياسة التربوية تهدف إلى تحقيق معدلات نجاح مرتفعة في الامتحانات الموحدة فقط، فإن أدوات التقويم ستقتصر على قياس الحفظ والاسترجاع للمعلومات.
من هذا المنطلق، فإن نتائج التقويم التربوي تمثل تغذية راجعة فعالة للسياسة التعليمية، فهي تكشف عن نقاط القوة والضعف في المناهج الدراسية، وفي طرائق التدريس، وفي كفاءة المعلمين، وحتى في عدالة توزيع الموارد التعليمية. وغالبًا ما تكون هذه النتائج محفزًا لاتخاذ قرارات إصلاحية كبرى، سواء من حيث تعديل البرامج والمقررات، أو مراجعة أساليب التقويم نفسها، أو إعادة النظر في منظومة تكوين المعلمين. بذلك، يصبح التقويم وسيلة لتطوير السياسة التربوية، وليس مجرد أداة للحكم أو التصنيف.
ومما يدعم هذه العلاقة الجدلية أن الدول التي تعتمد سياسات تربوية واضحة وواقعية، تنبني على معطيات علمية وبيانات دقيقة، غالبًا ما توظف تقويمًا تربويًا متقدمًا ومتعدد الأبعاد. فمثلًا، في بعض الأنظمة التربوية المتطورة كفنلندا وكندا، لا يُنظر إلى التقويم على أنه اختبار نهائي فقط، بل هو عملية مستمرة ومتكاملة تساهم في تحسين التعلم وليس فقط قياسه. هذه الأنظمة تدمج بين التقويم التكويني، الذي يرافق العملية التعليمية، والتقويم الإجمالي، الذي يقيم النتائج النهائية، مما يعكس فلسفة تربوية شمولية تنظر إلى التعليم كمسار لبناء الإنسان لا مجرد جسر للحصول على الشهادات.
وفي السياق الجزائري والعربي عمومًا، يمكن ملاحظة أن العلاقة بين التقويم والسياسة التربوية لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوطيد والوضوح. فكثيرًا ما يتم تطبيق إصلاحات تعليمية دون الاعتماد على نتائج تقويم موضوعي للمراحل السابقة، أو يتم إجراء اختبارات وطنية دون أن تُستثمر نتائجها في تحسين المحتوى التعليمي أو ظروف التمدرس. كما أن التركيز المفرط على المعدلات ونسب النجاح قد يحجب المشكلات الحقيقية في جودة التعليم، مثل ضعف مهارات الفهم، أو غياب التفكير النقدي، أو ضعف العلاقة بين المدرسة وسوق العمل.
من بين الإشكاليات الكبرى التي تكشفها ممارسات التقويم التربوي في واقعنا، نجد غياب العدالة في التقييم بسبب الفوارق الجغرافية والاجتماعية، وضبابية المعايير في بعض الاختبارات، إضافة إلى الضعف في تكوين الفاعلين التربويين على ثقافة التقويم البنّاء. هذه الممارسات قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة، وبالتالي إلى قرارات سياسية غير ملائمة أو حتى مضللة. لذا فإن تطوير العلاقة بين التقويم والسياسة التربوية يقتضي تكوينًا منهجيًا للمعلمين والإداريين في مجالات التقويم، مع دعم استقلالية الهيئات المكلفة به، واستعمال أدوات حديثة تجمع بين الدقة والموضوعية، مثل الأنظمة الرقمية وتقنيات تحليل البيانات الكبرى.
وفي الختام، فإن التقويم التربوي لا يمكن فصله عن الإطار العام للسياسة التربوية، بل يجب أن يُبنى في ضوء الأهداف الكبرى التي تسطرها الدولة، وفي الوقت ذاته يجب أن يُسهم في تصحيح مسار هذه السياسة بناءً على النتائج الميدانية. فحين يُمارَس التقويم بمهنية وشفافية، يمكن له أن يكون ليس فقط مرآة للسياسة التربوية، بل أداة لتقويمها ومرافقتها نحو تحقيق تعليم أكثر عدالة وفعالية وجودة.
-


السوسيولوجية في تطوير نماذج تقويمية
أهداف المحاضرة
uفهم العلاقة بين البحث السوسيولوجي والنماذج التربوية للتقويم
uتوضيح كيف يمكن للبحوث الاجتماعية أن تكشف الجوانب غير المرئية في الأنظمة التربوية التقليدية.uتحليل أثر البنية الاجتماعية والثقافية في أدوات التقويمملخص موسّع لمحاضرة: دور البحوث السوسيولوجية في تطوير نماذج تقويمية أكثر شمولية
تسعى هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه البحوث السوسيولوجية في تطوير مقاربات جديدة وشاملة للتقويم التربوي. لقد أصبح من الواضح أن النماذج التقويمية التقليدية، القائمة في الغالب على الاختبارات الكمية والنتائج الرقمية، غير قادرة على استيعاب التعقيد الاجتماعي والثقافي والنفسي الذي يطبع واقع المتعلم داخل المؤسسة التربوية. وهنا يأتي دور علم الاجتماع التربوي باعتباره أداة تحليلية ونقدية تمكن من فهم أعمق للمؤسسات التعليمية وتفاعلاتها.
في البداية، تقدم المحاضرة تعريفًا للبحوث السوسيولوجية في سياقها التربوي، باعتبارها دراسات منهجية تهدف إلى تحليل العلاقة بين التربية والمجتمع، من خلال البحث في أوجه التفاوت الاجتماعي، والتمييز الثقافي، والبنية الطبقية التي تؤثر في فرص التعليم والتحصيل الدراسي. فالتلميذ لا يأتي إلى القسم وهو "صفحة بيضاء"، بل يدخل محمّلًا برأسمال اجتماعي وثقافي قد يسهم في تقدمه أو يعيق مساره، حسب مدى تطابقه مع النموذج الثقافي السائد في المدرسة.
ثم تنتقل المحاضرة إلى نقد النماذج التقويمية التقليدية، التي غالبًا ما تفترض أن جميع المتعلمين ينطلقون من نفس النقطة، وتُقيّمهم وفق معايير موحدة، متجاهلة الفروق في الخلفيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. هذا التجاهل يؤدي إلى إعادة إنتاج التفاوت بدل تجاوزه، ويؤسس لفكرة أن الفشل المدرسي ناتج عن قصور ذاتي، في حين أن البحوث السوسيولوجية تؤكد أنه ناتج عن عوامل بنيوية.
تؤكد المحاضرة أن البحوث السوسيولوجية قادرة على المساهمة في بناء نماذج تقويمية أكثر عدالة وشمولًا، من خلال:
- اقتراح أدوات تقييم تضع في اعتبارها البيئة الاجتماعية والنفسية للمتعلمين.
- إدماج مؤشرات غير تقليدية في التقييم، مثل القدرة على التعاون، روح المبادرة، والاندماج الاجتماعي.
- تحليل أداء التلاميذ في ضوء مؤشرات مثل الفقر، التهميش، التمييز الثقافي أو الجندري.
- تقديم رؤية نقدية تسهم في تحسين السياسات التعليمية وتوجيه برامج الدعم.
كما تم استعراض بعض التجارب البحثية التي أثبتت أهمية المقاربة السوسيولوجية في مجال التقويم، من بينها دراسات عالم الاجتماع الفرنسي "بيير بورديو" الذي بيّن كيف تساهم المدرسة في إعادة إنتاج الفوارق الطبقية عبر آليات تقويمية غير عادلة، وكذلك تجارب دول مثل كندا وفنلندا التي طورت تقويمات متعددة الأبعاد تراعي خصوصية كل متعلم وسياقه.
تُختتم المحاضرة بالتأكيد على أن البحوث السوسيولوجية لا تكتفي بوصف الواقع التربوي، بل تسعى إلى تغييره من خلال اقتراح نماذج تقويمية أكثر إنصافًا وشمولًا، تُمكّن من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء بالعملية التربوية.
-
محاضرة لطلبة ماستر1 علم الاجتماع التربية
-
محاضرة لطلبة ماستر 1 علم الاجتماع التربية
-
لطلبة ماستر علم الاجتماع التربية
-
رابط فيديوا محاضرة: دور البحوث السوسيولوجية في تطوير نماذج تقويمية أكثر شمولية
-
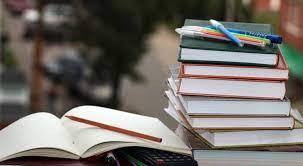
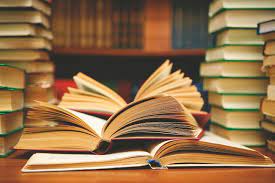
قائمة المراجع
1. عدس، عبد الرحمن، التقويم التربوي: أسسه، أنواعه، أدواته، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمّان، 2005
2. زيدان، حسن حسين ، القياس والتقويم في العملية التدريسية، دار الفكر عمان، 2010
3. ملحم، سامي محمد، القياس والتقويم التربوي والنفسي، دار المسيرة، عمان، 2012
4. نشواتي، عبد المجيد، أسس التقويم التربوي، دار الفكر، عمّان، 2004
5. أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف، أخطاء التقويم التربوي: تحليل نقدي، دار الوفاء، القاهرة. 2018
6. عبد المجيد، زينب ، تقويم التعليم في عصر الرقمنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2021
7. زكريا، عبد الله ، التقويم التربوي في ضوء النظرية السوسيولوجية، منشورات الجامعة الجزائر، 2019
8. أبو حطب، فؤاد ، السياسات التربوية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة،2003
9. محمد، عبد الباسط ، البحث التربوي والسوسيولوجيا، دار النهضة العربية، بيروت، 2020