القانون الدستوري والنظم السياسية
Résumé de section
-
الاستاذ فخر الدين ميهوبي
استاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية محاضر أ
الايميل المهني fakhreddine.mihoubi@univ-biskra.dz
0770191926
ايام العمل الاحد والثلاثاء صباحا من كل اسبوع
-

دراسة مقياس القانون الدستوري لطلبة السنة الأولى من حقوق جذع مشترك
تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، منها:
فهم طبيعة الدولة ونظام الحكم
- تعريف الطالب بمفهوم الدولة (أركانها: الشعب، الإقليم، السلطة السياسية، السيادة).
- تحليل أشكال الدولة (بسيطة، مركبة، اتحادية...) وأنظمة الحكم (رئاسي، برلماني، مختلط).معرفة الدستور ومبادئه
- تعريف الدستور (مفهومه، أنواعه: مكتوب/غير مكتوب، مرن/جامد).
- دراسة مبدأ **سمو الدستور** وعلاقته بالقوانين العادية.
- كيفية وضع الدساتير وتعديلها (السلطة التأسيسية الأصلية والفرعية).إدراك مبدأ فصل السلطات
- نظرية **مونتسكيو** (الفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية، والقضائية).
- تطبيقات الفصل بين السلطات في الأنظمة الدستورية المختلفة.ضمان حقوق الحريات الأساسية
- دراسة **الحقوق والحريات** في الدستور (الحرية، المساواة، الأمن...).
- دور القضاء الدستوري في حماية هذه الحقوق (من خلال الرقابة على دستورية القوانين).التحضير للمواد القانونية الأخرى
- يُعد القانون الدستوري أساسًا لفهم فروع القانون الأخرى مثل:
- القانون الإداري (تنظيم السلطة التنفيذية).
- القانون الدولي (علاقة الدولة بالمنظمات الدولية).تعزيز الثقافة القانونية والسياسية
- تنمية وعي الطالب بالحياة السياسية والمؤسسات الدستورية في بلده.
- فهم آليات المشاركة الديمقراطية (الانتخابات، الأحزاب، المجتمع المدني).تطوير مهارات التحليل والنقد
- مقارنة الدساتير (مثال: المقارنة بين الدستور الجزائري، الفرنسي، الأمريكي...).
- مناقشة إشكاليات مثل: التوازن بين السلطات، الرقابة على الدستورية، الطوارئ الدستورية. -
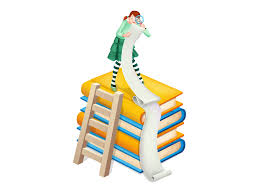
1- الحكومة وأشكالها
3- مبدأ الفصل بين السلطات
8- أنماط الاقتراع وتطبيقاتها في الجزائر
9- الأحزاب السياسية وطرق اعتمادها
-
1- الحكومة وأشكالها
تُعد دراسة مفهوم الحكومة وأشكالها من الموضوعات المركزية في فقه النظم السياسية والقانون الدستوري، لما لها من ارتباط وثيق بكيفية تنظيم السلطة في الدولة، وتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات، وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ومن خلال هذا البحث، سنسعى إلى تقديم دراسة تحليلية مقارنة لمفهوم الحكومة وتعدد دلالاته، ثم تصنيف أشكال الحكومات وفق معايير مختلفة تتصل بموقع السلطة ومصدرها وطريقة ممارستها.
يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن، من خلال تحليل النصوص الدستورية، واستعراض آراء فقهاء القانون، بهدف التوصل إلى تحديد دقيق لمفهوم الحكومة وتمييز أشكالها.المبحث الأول: تعريف الحكومة وتعدد دلالاتها
المطلب الأول: الحكومة كجهاز تنفيذي
يُستخدم مصطلح "الحكومة" في الفقه السياسي والدستوري للإشارة إلى الجهاز التنفيذي للدولة، ويختلف المعنى باختلاف النظام السياسي المعتمد. ففي النظم البرلمانية يُقصد بها "الوزارة"، أي الهيئة التنفيذية المسؤولة أمام البرلمان، بينما في النظم الرئاسية فإن "الحكومة" تشمل رئيس الدولة وأعضاء الجهاز التنفيذي كافة، دون أن تكون مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
وقد جاء في بعض الدساتير أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية العليا في الدولة، وهو ما يعكس توسعًا في مدلول المصطلح ليشمل كل من يضطلع بالوظيفة التنفيذية في الدولة .المطلب الثاني: الحكومة كنظام حكم
إلى جانب المعنى التنفيذي، يُستعمل مصطلح الحكومة للدلالة على نظام الحكم القائم، أي الكيفية التي تُمارَس بها السلطة السياسية، سواء في ظل ملكية أو جمهورية، استبداد أو ديمقراطية. ويعكس هذا المعنى البُعد المؤسساتي للحكم، حيث تُمثّل الحكومة مجمل السلطات الثلاث داخل الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) من حيث التنظيم والصلاحيات .
كما أن بعض الدساتير القديمة كانت تستخدم تعبير "حكومتها ملكية" للإشارة إلى طبيعة النظام السياسي برمته، لا إلى الجهاز التنفيذي فقط .
المبحث الثاني: تصنيف أشكال الحكومة
المطلب الأول: من حيث الخضوع للقانون
تنقسم الحكومات وفق معيار الخضوع للقانون إلى حكومات استبدادية وحكومات قانونية.
الحكومة الاستبدادية هي التي لا تلتزم بأي قيود قانونية، حيث تنفرد السلطة التنفيذية بالحكم دون رقابة دستورية أو شعبية .
الحكومة القانونية هي التي تخضع للقانون، سواء في شكلها المطلق حيث تُمارَس السلطة في إطار قانوني شكلي، أو في شكلها المقيد، حيث تخضع السلطة لرقابة فعلية من قِبل مؤسسات دستورية أخرى .المطلب الثاني: من حيث طبيعة الرئيس الأعلى للدولة
يمكن التمييز بين الحكومة الملكية، حيث يتولى الحكم شخص يُنصَّب بالوراثة مدى الحياة، والحكومة الجمهورية، حيث يتم انتخاب رئيس الدولة لفترة محددة.
في الملكية، يُعد الملك مصدرًا للسلطات، بينما في الجمهورية تُستمد السلطة من الإرادة الشعبية. ولكل منهما تطبيقاته المتعددة في الدول المعاصرة، سواء في إطار أنظمة رئاسية أو شبه رئاسية.المطلب الثالث: من حيث مصدر السيادة
تصنَّف الحكومات أيضًا حسب مصدر السيادة إلى:
حكومة الفرد، حيث تتركز السلطة بيد شخص واحد، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالنظم الملكية المطلقة أو الديكتاتوريات الشخصية.
حكومة القلة، حيث تُمارَس السلطة من قِبل فئة محدودة، قد تكون من النخبة الأرستقراطية أو من الطبقة الاقتصادية أو العسكرية، كما في حكومات الأوليغارشية أو العسكرية .
الحكومة الديمقراطية، حيث تُستمد السيادة من الشعب، وتمارس من خلال أساليب مباشرة أو غير مباشرة، ما يجعلها أكثر شرعية من الناحية السياسية والدستورية .الاستنتاجات
1. يتسم مصطلح الحكومة بتعدد دلالاته، مما يعكس غناه المفاهيمي بين البعد التنفيذي والبعد النظمي.
2. تتعدد أشكال الحكومة حسب معايير الخضوع للقانون، طبيعة الرئيس الأعلى، ومصدر السيادة.
3. تمثل الحكومة القانونية المقيدة نموذجًا لممارسة السلطة في إطار من الرقابة والتوازن، بينما تُجسد الحكومة الاستبدادية نموذجًا لتغوّل السلطة وغياب المشروعية.الأسئلة التقييمية
1. ما الفرق بين الحكومة كجهاز تنفيذي والحكومة كنظام حكم؟
2. كيف يؤثر شكل الحكومة على العلاقة بين السلطات داخل الدولة؟
3. ما أوجه التشابه والاختلاف بين الحكومة القانونية المطلقة والحكومة القانونية المقيدة؟4. إلى أي مدى يمكن القول إن النظام الجمهوري أكثر ديمقراطية من النظام الملكي؟
5. هل تعني الحكومة الاستبدادية بالضرورة غياب القانون؟ وضّح بمثال.
6. ما هي معايير تصنيف الحكومات من حيث مصدر السيادة؟ وكيف تختلف حكومة الفرد عن حكومة القلة؟
7. في رأيك، هل يمكن الجمع بين الحكومة الديمقراطية والحكومة الملكية؟ استدل بأمثلة واقعية. -
تعد الديمقراطية من أكثر المفاهيم السياسية إثارة للنقاش في الفكر السياسي الحديث والمعاصر، لما لها من أبعاد فلسفية وتطبيقية تمس جوهر العلاقة بين السلطة والشعب. وقد عرفت الديمقراطية منذ نشأتها الأولى في المدن اليونانية القديمة، لا سيما أثينا، تطوراً كبيراً، انعكس في نماذج مختلفة باختلاف السياقات التاريخية والثقافية للدول.
يرتكز هذا البحث على منهج وصفي تحليلي، هدفه تقديم معالجة علمية شاملة لمفهوم الديمقراطية من خلال تتبع أصولها، استجلاء خصائصها الأساسية، وتحليل صورها المختلفة، مع ربطها بالإطار النظري والممارسات التطبيقية في الأنظمة السياسية الحديثة.
أولاً: مفهوم الديمقراطية
1.1 النشأة التاريخية
ظهر مصطلح الديمقراطية لأول مرة في اليونان القديمة، وكان يشير إلى شكل من الحكم يمارسه المواطنون الأحرار بشكل مباشر، دون وسيط[1]. وفي أثينا، كان يتم اتخاذ القرارات عبر التجمع العام للمواطنين، الذين يناقشون ويصوّتون على السياسات والقوانين. لكن هذا النموذج كان مقصوراً على فئة معينة من السكان، ما يطرح تساؤلات حول مدى "ديمقراطيته".
1.2 التعريفات الحديثة
من بين أهم التعريفات المعاصرة، يُعتبر تعريف روبرت دال () الأكثر شهرة، حيث يعرّف الديمقراطية بأنها "نظام سياسي يتضمن مؤسسات تضمن المنافسة بين النخب، وتكفل المشاركة السياسية المتكافئة للمواطنين[2]، وتسمح بممارسة الحريات السياسية" (
أما فريد زكريا (Fareed Zakaria) فقد ميّز بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الإجرائية، منتقداً الأنظمة التي تجري انتخابات دون أن تحترم الحقوق الفردية والحريات العامة[3]
ثانياً: خصائص الديمقراطية
للديمقراطية خصائص مميزة تجعلها تختلف عن غيرها من الأنظمة السياسية، ويمكن تلخيصها كما يلي:
2.1 السيادة الشعبية
الشعب في الديمقراطية هو مصدر السلطة. يتم التعبير عن هذه السيادة عبر الانتخابات العامة، التي تُجرى بشكل دوري ونزيه (الحسن، 2021، ص. 14). وهي التي تتيح تداول السلطة بشكل سلمي.
2.2 التعددية السياسية والحزبية
تشجع الديمقراطية على وجود أكثر من حزب سياسي، بما يضمن التنافس الحر على السلطة، ويمنع احتكارها من طرف جهة واحدة [4]
2.3 الفصل بين السلطات
هذا المبدأ، الذي نظّر له مونتسكيو في كتابه روح القوانين، يهدف إلى خلق توازن يمنع الاستبداد من خلال توزيع السلطة بين الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية .[5]
2.4 حماية الحقوق والحريات
الديمقراطية تُؤسس على احترام الحريات الأساسية: حرية التعبير، حرية التنظيم، حرية الصحافة، وحرية الضمير، وكلها تضمن وجود بيئة سياسية مفتوحة .[6]
2.5 الشفافية والمساءلة
من أهم وظائف الديمقراطية أنها تضع آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين عبر الرقابة البرلمانية، والتقارير الدورية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام [7]
ثالثاً: صور الديمقراطية
تعددت نماذج الديمقراطية عبر العصور، وتبلورت صور متنوعة منها بحسب التطور السياسي للمجتمعات:
3.1 الديمقراطية المباشرة
وفيها يمارس المواطنون سلطاتهم بأنفسهم دون وساطة، كما كان الحال في أثينا القديمة. يُعتبر هذا الشكل نادراً اليوم، ويُطبّق جزئياً في بعض الكانتونات السويسرية [8]
3.2 الديمقراطية التمثيلية
وهي النموذج السائد في معظم دول العالم، إذ يتم انتخاب ممثلين يتولون مهام التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، مثل البرلمان في بريطانيا أو الكونغرس في الولايات المتحدة .[9]
3.3 الديمقراطية شبه المباشرة
تمثل حلاً وسطاً بين النمطين السابقين، حيث يتمكن المواطنون من التأثير المباشر عبر آليات مثل الاستفتاء والمبادرات الشعبية والاعتراض الشعبي، كما هو الحال في النظام السياسي السويسري.
3.4 الديمقراطية الليبرالية
تدمج بين مبادئ الديمقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية، مع تأكيد خاص على سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية. غالباً ما ترتبط بالدول الغربية المتقدمة.
3.5 الديمقراطية التشاركية
ظهرت هذه الصورة لتجاوز حدود الديمقراطية التمثيلية التقليدية، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المواطن في اتخاذ القرار السياسي على المستوى المحلي أو المؤسسي، وغالباً ما تكون مرتبطة بالحكم المحلي.
رابعاً: التحديات المعاصرة للديمقراطية
رغم انتشار الديمقراطية وتعدد أشكالها، فإنها تواجه عدداً من التحديات في العصر الحديث، نذكر منها:
صعود الشعبوية: التي تستغل الوسائل الديمقراطية للوصول إلى السلطة ثم تقويضها من الداخل
ضعف المشاركة السياسية: نتيجة عزوف المواطنين عن الانتخابات أو انعدام الثقة في الفاعلين السياسيين.
تأثير رأس المال والإعلام: الذي يؤثر على نزاهة العمليات الانتخابية ويخلق تفاوتاً في النفوذ السياسي [10]
الأنظمة الهجينة: التي تمزج بين الاستبداد والديمقراطية، فتسمح بانتخابات صورية دون وجود حقيقي للمنافسة أو الحقوق.
خاتمة واستنتاجات
يتضح من هذا التحليل أن الديمقراطية ليست مجرد آليات انتخابية، بل منظومة متكاملة من المبادئ التي تضمن حكم الشعب، احترام الحقوق، والتداول السلمي للسلطة. ومع أن الممارسة الديمقراطية تختلف من دولة لأخرى، فإن القيم المشتركة تظل قائمة على سيادة الشعب، المشاركة السياسية، واحترام الحريات.
لكن الديمقراطية ليست نهاية التاريخ، بل مشروع دائم التطور، يتطلب يقظة مستمرة، ومؤسسات قوية، وثقافة سياسية تضمن استدامته.
الأسئلة التقييمية
1. قارن بين الديمقراطية المباشرة والتمثيلية مع ذكر مثال لكل منهما.
2. ناقش كيف تحقق التعددية السياسية مبدأ المساءلة في النظام الديمقراطي.
3. ما التحديات التي تواجه الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة؟
موعد المحاضرة القادمة: مبدأ الفصل بين السلطات.
[1] محمد عبد الفتاح، مقدمة في النظم السياسية. القاهرة: دار المعرفة، 2019.ص. 45
[2] Dahl, Robert. On Democracy. Yale University Press, 2000., p. 37.
[3] Zakaria, Fareed. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W.W. Norton, 2003. p. 26.
[4] أبو زيد، حسام. النظم السياسية والقانون الدستوري. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، 2020.ص. 91).
[5] Montesquieu, Charles. The Spirit of the Laws. 1748.
[6] محمد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص. 112).
[7] Dahl, Ibid.
[8] عويضة، سامي. "النموذج السويسري للديمقراطية المباشرة"، مجلة الفكر السياسي، العدد 32، 2022 ص. 33).
[9] (أبو زيد، مرجع سابق، ص. 123).
[10] الحسن، نادر. "الديمقراطية في الفكر السياسي المعاصر"، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 55، 2021
-
يُعتبر النظام البرلماني البريطاني نموذجًا تاريخيًا فريدًا تطور عبر ثمانية قرون، حيث يمثل حالة استثنائية في الاستمرارية الدستورية. يعتمد هذا النظام على "الدستور غير المكتوب" الذي يتكون من سلسلة من القوانين والتقاليد والسوابق التاريخية. تكمن قوته في مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية مع الحفاظ على الجوهر الديمقراطي[1].
أولاً: النشأة والتطور التاريخي
1. الجذور التاريخية
تعود أصول البرلمان البريطاني إلى "المجلس الملكي الكبير" في العصور الوسطى، حيث كان يجتمع النبلاء ورجال الدين لتقديم المشورة للملك. تحول هذا المجلس تدريجياً إلى هيئة تشريعية بعد صراع طويل مع الملوك، خاصة بعد الماغنا كارتا التي فرضت لأول مرة مبدأ خضوع الملك للقانون.[2]
2. مراحل التطور
أ- مرحلة الملكية المقيدة: شهدت تقليصًا تدريجيًا لسلطات التاج لصالح البرلمان، حيث أصبحت الموافقة البرلمانية ضرورية لفرض الضرائب وإصدار القوانين.[3]
ب- مرحلة الديمقراطية البرلمانية: تميزت بتوسيع قاعدة الانتخاب وإصلاح النظام الانتخابي، مما عزز الشرعية الشعبية للبرلمان.[4]
ج- المرحلة المعاصرة: اتسمت بترسيخ دور رئيس الوزراء كقوة سياسية مركزية، مع تقليص دور الملك إلى مجرد رمز دستوري.
ثانياً: المبادئ الدستورية:
1. سيادة البرلمان :
تعني أن البرلمان يتمتع بالسلطة المطلقة في التشريع، دون وجود دستور مكتوب يحد من صلاحياته. يمكن للبرلمان تعديل أي قانون أو إلغائه دون قيود، بما في ذلك القوانين الدستورية نفسها.[5]
2. المسؤولية الوزارية:
تتجلى في صورتين:
- المسؤولية الجماعية: حيث يجب على جميع الوزراء دعم قرارات الحكومة علنًا
- المسؤولية الفردية: كل وزير مسؤول عن أداء وزارته.[6]
3. عدم مسؤولية الملك
يعني أن الملك لا يمكن محاسبته قانونيًا أو سياسيًا عن أي قرار، حيث أن التوقيع الملكي على القرارات يحتاج إلى عَضْد وزير (Counter-signature) الذي يتحمل المسؤولية بدلاً عنه[7]
ثالثاً: هيكل السلطات
1. السلطة التنفيذية
أ. الملك: تقوم بوظائف رمزية مثل افتتاح الدورات البرلمانية، وتعيين رئيس الوزراء، ومنح الموافقة الملكية على القوانين. عمليًا، تمارس هذه الصلاحيات بناء على مشورة الوزراء
ب. رئيس الوزراء: يقود حزب الأغلبية في مجلس العموم، ويوجه السياسة العامة، ويعين ويقيل الوزراء. تتركز في يديه صلاحيات واسعة تشمل حتى تحديد موعد الانتخابات
ج. مجلس الوزراء: يتكون من 20-25 وزيرًا رئيسيًا، وهو مركز صنع القرار الحقيقي. تجتمع الحكومة الكبيرة (Ministry) التي تضم جميع الوزراء نادرًا، بينما يعمل مجلس الوزراء (Cabinet) بشكل أسبوعي
2. السلطة التشريعية:
أ. مجلس العموم: يتم انتخاب أعضائه كل 5 سنوات (حسب القانون الحالي) بنظام الأغلبية البسيطة. يمتلك السلطة الحقيقية في التشريع والرقابة على الحكومة
ب. مجلس اللوردات: يتكون من أعضاء غير منتخبين (حاليًا حوالي 800 عضو)، يقدمون الخبرة في مراجعة التشريعات ولكن بصلاحيات محدودة بعد الإصلاحات الدستورية الأخيرة
3. السلطة القضائية
حصلت على استقلال كامل عن البرلمان عام 2009 بإنشاء المحكمة العليا. كانت القضايا الدستورية الكبرى تنظر سابقًا من قبل لجنة قضائية في مجلس اللوردات
رابعاً: آليات العمل
1. الرقابة البرلمانية
- جلسات الأسئلة: خاصة "أسئلة رئيس الوزراء" الأسبوعية
- لجان التحقيق: تفحص عمل الحكومة بتفصيل دقيق
- التصويت على الثقة: يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة
2. العمل التشريعي
تمر القوانين بمراحل متعددة في كلا المجلسين، مع إمكانية تعطيل مجلس اللوردات للتشريعات لمدة محدودة فقط
3. علاقة المؤسسات
تقوم على التوازن الدقيق بين:
- حق الحكومة في حل البرلمان
- حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة
الاستنتاجات
يقدم النظام البريطاني دروسًا مهمة في التطور الدستوري العضوي، حيث تتفاعل المؤسسات السياسية مع التغييرات المجتمعية دون قطع مع التقاليد. رغم التحديات، يظل هذا النظام قادرًا على التكيف مع الحفاظ على استقراره الأساسي.
الأسئلة التقويمية
أ. ما المقصود بمبدأ "الملك يملك ولا يحكم" في النظام البريطاني؟
ب. عدد ثلاثًا من خصائص النظام البرلماني البريطاني؟
ج. كيف يضمن النظام البريطاني التوازن بين السلطات؟
-
النظام السياسي الرئاسي: الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً
مقدمة
المبحث الأول: الإطار المفهومي للنظام الرئاسي
المطلب الأول: تعريف النظام الرئاسي ومقوماته
المطلب الثاني: نشأة النظام الرئاسي وتطوره التاريخي
المطلب الثالث: تمييز النظام الرئاسي عن غيره من الأنظمة السياسية
المبحث الثاني: البناء الدستوري والسياسي للنظام الرئاسي الأمريكي
المطلب الأول: المبادئ العامة للنظام السياسي الأمريكي
المطلب الثاني: السلطات العامة في النظام الرئاسي الأمريكي
المطلب الثالث: آلية الرقابة والتوازن بين السلطات
المبحث الثالث: تقييم النظام الرئاسي الأمريكي
المطلب الأول: مزايا النظام الرئاسي الأمريكي
المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة للنظام الرئاسي الأمريكي
المطلب الثالث: مدى قابلية تطبيق النموذج الأمريكي في أنظمة سياسية أخرى
الاستنتاجات
مقدمة
يمثل النظام الرئاسي أحد أبرز الأشكال الحكومية الحديثة، وقد اكتسب أهمية خاصة نتيجة اعتماده في دولة تعتبر من أعتى الديمقراطيات في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. إن دراسة هذا النظام تفرض التطرق إلى أبعاده التاريخية والدستورية والسياسية، والتعرف على خصائصه التي تميّزه عن باقي الأنظمة، خاصة النظام البرلماني. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على طبيعة الفصل بين السلطات وآليات التوازن والرقابة، مما يعكس تجربة سياسية غنية تستحق البحث والتأمل.
المبحث الأول: الإطار المفهومي للنظام الرئاسي
تعريف النظام الرئاسي ومقوماته
يُعرف النظام الرئاسي بأنه النظام الذي يقوم على الفصل التام بين السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، مع وجود آليات للتوازن والرقابة المتبادلة فيما بينها[1] ويقوم هذا النظام على عدة مقومات منها: انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وعدم مسؤولية الرئيس أمام البرلمان، واستقلالية السلطة القضائية.
نشأة النظام الرئاسي وتطوره التاريخي
نشأ النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787 مع صدور الدستور الأمريكي، كرد فعل على تجربة الحكم البريطاني الذي جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما أدى إلى تبني مبدأ الفصل الصارم بين السلطات[2]
تمييز النظام الرئاسي عن غيره من الأنظمة السياسية
يُميَّز النظام الرئاسي عن النظام البرلماني في كون رئيس الدولة هو رئيس الحكومة، ولا يخضع للمساءلة السياسية أمام البرلمان. كما يختلف عن النظام شبه الرئاسي بكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية محدودة للغاية[3]
المبحث الثاني: البناء الدستوري والسياسي للنظام الرئاسي الأمريكي
المبادئ العامة للنظام السياسي الأمريكي
يقوم النظام السياسي الأمريكي على مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها:
السيادة الشعبية، حكم القانون، الفصل بين السلطات، الضوابط والتوازنات Checks and Balances
السلطات العامة في النظام الرئاسي الأمريكي
السلطة التنفيذية
تتجسد في شخص الرئيس، الذي يُنتخب من قبل الشعب بشكل غير مباشر عبر المجمع الانتخابي، ويمارس اختصاصات واسعة تشمل تعيين كبار المسؤولين، قيادة القوات المسلحة، وإبرام المعاهدات
السلطة التشريعية
تتمثل في الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، وهو صاحب الاختصاص في التشريع، والمراقبة المالية، وإعلان الحرب، بالإضافة إلى سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال لجان الاستماع والتحقيق
السلطة القضائية
تتمثل في المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية، وتمارس اختصاص الرقابة الدستورية، وتفسير القوانين، والفصل في النزاعات الفيدرالية.
آلية الرقابة والتوازن بين السلطات
يكرّس النظام الأمريكي مبدأ التوازن بين السلطات، حيث يملك الكونغرس صلاحية عزل الرئيس، كما يملك الرئيس حق الاعتراض على القوانين (الفيتو)، وتراقب المحكمة العليا دستورية أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية
المبحث الثالث: تقييم النظام الرئاسي الأمريكي
مزايا النظام الرئاسي الأمريكي
من أبرز مزاياه: الاستقرار السياسي نتيجة ثبات السلطة التنفيذية،
وضوح المسؤوليات، منع تغول سلطة على أخرى
الانتقادات الموجهة للنظام الرئاسي الأمريكي
من الانتقادات: إمكانية حدوث شلل سياسي في حالة الانقسام الحزبي، صعوبة إقالة الرئيس، تركز السلطة في يد شخص واحد
مدى قابلية تطبيق النموذج الأمريكي في أنظمة سياسية أخرى
يُجمع العديد من الباحثين أن نموذج النظام الرئاسي الأمريكي صعب التطبيق في الدول ذات المؤسسات الهشة أو التجربة الديمقراطية الناشئة، لما يتطلبه من توازن دقيق ومؤسسات مستقلة فعالة[4].
الاستنتاج
خلصت الدراسة إلى أن النظام الرئاسي الأمريكي يمثل نموذجاً فريداً في التنظيم السياسي، وقد استطاع الصمود لأكثر من قرنين بفضل آليات التوازن والرقابة. ومع ذلك، فإنه ليس خالياً من العيوب، ولا يمكن نسخه ببساطة في بيئات سياسية مختلفة دون مراعاة الخصوصيات الثقافية والمؤسساتية.
أسئلة تقييمية:
1. عرّف النظام السياسي الرئاسي، واذكر أبرز خصائصه؟
2. ما الفرق الجوهري بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني؟
3. ما المقصود بمبدأ "الفصل بين السلطات" في النظام الأمريكي؟
[1] عيسى، مصطفى. النظم السياسية المقارنة. دار الهدى، 2018.
[2] عبد الحميد، نبيل. تاريخ النظم السياسية. دار الكتاب الجامعي، 2016.
[3] الديب، محمد. مدخل إلى علم السياسة. منشورات جامعة القاهرة، 2020.
[4]. Horowitz, Donald. Constitutional Change and Democracy in Indonesia. Cambridge University Press, 2013.
-
للنظام السياسي المختلط النظام الفرنسي نموذجا
مقدمة
يُمثل النظام السياسي الفرنسي بموجب دستور 1958 نموذجًا فريدًا يجمع بين عناصر النظام البرلماني والرئاسي، مما جعله يُصنف في الفقه الدستوري تحت مسميات متعددة مثل "النظام المختلط" أو "النظام شبه الرئاسي". جاء هذا النظام استجابة لأزمات الجمهورية الرابعة (1946-1958)، التي عانت من عدم الاستقرار الحكومي (29 حكومة في 12 عامًا)[1]. يهدف هذه الدرس إلى تقديم تحليل شامل لهذا النظام من خلال:
1. الأسس الدستورية والتاريخية للنظام المختلط.
2. الهيكل المؤسسي وتوزيع السلطات.
3. آليات التفاعل بين السلطات.
4. التطبيقات العملية
5. تقييم النظام في ضوء التعديلات الدستورية والتحديات المعاصرة.
أولاً: الأسس الدستورية والتاريخية للنظام المختلط
السياق التاريخي
- إخفاق الجمهورية الرابعة: بسبب هيمنة البرلمان وضعف السلطة التنفيذية، مما أدى إلى أزمات متكررة (مثل أزمة الجزائر 1958).
- دور ديغول: كلفه الرئيس "رينيه كوتي" بتشكيل حكومة لوضع دستور جديد يعزز سلطة الرئيس[2]
2. الفلسفة الدستورية
-عقلنة البرلمانية (Parlementarisme rationalisé): تقييد سلطة البرلمان لصالح السلطة التنفيذية عبر آليات مثل:
- تحديد جدول أعمال البرلمان (المادة 48).
- تقييد اقتراح القوانين المالية (المادة 40).
تعزيز شرعية الرئيس بجعله منتخبًا مباشرةً من الشعب (تعديل 1962).
ثانياً: الهيكل المؤسسي وتوزيع السلطات
1. السلطة التنفيذية: ثنائية القيادة
- رئيس الجمهورية، ُنتخب مباشرة (5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة).
- الحكومة (رئيس الوزراء والوزراء)يُعين من قبل الرئيس، ولكن يجب أن يحظى بثقة البرلمان
- صلاحيات واسعة (تعيين رئيس الوزراء، حل البرلمان، المادة 16).
- مسؤولة أمام البرلمان (المادة 49).
| - يترأس مجلس الوزراء (المادة 9).
- توجيه السياسة العامة (المادة 20).
التعايش (Cohabitation):
عندما لا يملك الرئيس أغلبية برلمانية، يضطر إلى تعيين رئيس حكومة من المعارضة، مما يقلص صلاحياته (مثل حالة ميتران وشيراك 1986-1988)[3]
2. السلطة التشريعية (البرلمان)
- الجمعية الوطنية
- تُنتخب مباشرة لمدة 5 سنوات (577 عضوًا).
- تملك سلطة سحب الثقة (المادة 49).
- مجلس الشيوخ
- يُنتخب غير مباشر (348 عضوًا، 6 سنوات). - دور استشاري، ولا يمكن حله.
3. المؤسسات الرقابية
- المجلس الدستوري : يفحص دستورية القوانين (المادة 61).
- يُعين أعضاؤه من قبل الرئيس ورؤساء البرلمان (9 أعضاء).
- المجلس الأعلى للقضاء: يضمن استقلالية القضاء (المادة 65).
ثالثاً: آليات الت
1. آليات الضبط المتبادل
| السلطة التنفيذية - حل الجمعية الوطنية (المادة 12). استخدام المادة 49.3 لإجازة القوانين دون تصويت
السلطة التشريعية سحب الثقة من الحكومة (المادة 49). تعديل الدستور (بموافقة 3/5 البرلمان).
2. التشريع والعمل الحكومي
- الحكومة تملك حق المبادرة التشريعية (70% من القوانين مصدرها الحكومة)[4]
- التفويض التشريعي (المادة 38): يمكن للحكومة التشريع بأمر في مجالات محددة.
رابعاً: التطبيقات العملية للنظام
1. فترات التعايش
- 1986-1988الرئيس الاشتراكي (ميتران) مع رئيس حكومة محافظ (شيراك).
- 1997-2002الرئيس المحافظ (شيراك) مع رئيس حكومة اشتراكي (جوسبان).
الآثار
- انتقال الصلاحيات من الرئيس إلى رئيس الحكومة.
- تعزيز الطابع البرلماني للنظام.
خامساً: تقييم النظام المختلط
الإيجابيات
المرونة: التحول بين الشكل الرئاسي والبرلماني حسب الأغلبية.
- استقرار الحكومة: مقارنةً بالجمهورية الرابعة.
السلبيات
- الغموض الدستوري: تداخل صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة.
- خطر الاستبداد: مع تطبيق المادة 16 (كما في أزمة الجزائر 1961).
الاستنتاجات
يظل النظام الفرنسي نموذجًا ناجحًا في التوفيق بين الاستقرار والمرونة، رغم انتقاده أحيانًا لتركيزه السلطة في يد الرئيس. التعديلات المستقبلية يجب أن تركز على:
1. توضيح صلاحيات الرئيس في حالات التعايش.
2. تعزيز الرقابة البرلمانية على الصلاحيات الاستثنائية.
الاسئلة التقييمية
1. ما هو النظام السياسي المختلط؟
أ) نظام يجمع بين خصائص النظام البرلماني والرئاسي
ب) نظام رئاسي بحت
ج) نظام برلماني تقليدي
2. ما هو النموذج الرئيسي للنظام المختلط؟
أ) النظام الأمريكي
ب) النظام البريطاني
ج) النظام الفرنسي
3. كيف يتم اختيار رئيس الدولة في النظام المختلط؟
أ) بالتعيين من البرلمان
ب) بالانتخاب المباشر من الشعب
ج) بالتوريث
4. ما الفرق الرئيسي بين النظام المختلط والنظام البرلماني؟
أ) وجود رئيس دولة منتخب مباشرة
ب) عدم وجود حكومة
ج) غياب البرلمان
[1] Maurice Duverger, *Échec au Roi: Les Orphelins de la République* (Paris: Albin Michel, 1994), p. 45.
[2] المادة 11 من الدستور الفرنسي (1958).
[3] حسن نافعة، *تعاقب السلطة في أوروبا* (القاهرة: دار الشروق، 2001)، ص 110.
[4] Olivier Duhamel, *Droit Constitutionnel et Institutions Politiques* (Paris: Seuil, 2010), p. 320.
-
نظام حكومة الجمعية النيابية ) النموذج السويسري (
اولا: مفهوم نظام حكومة الجمعية النيابية
ثانيا: الأسس الفلسفية لنظام حكومة الجمعية النيابية
ثالثا: الخصائص الأساسية لنظام حكومة الجمعية النيابية
رابعا: العلاقة بين السلطات في ظل نظام حكومة الجمعية النيابية
خامسا: تطبيق نظام حكومة الجمعية النيابية في الاتحاد السويسري
مقدمة
يقوم النظام النيابي أو التمثيلي على وجود برلمان منتخب يعبر عن الإرادة الشعبية، ويعد نظام حكومة الجمعية (Régime d'assemblée) أحد أشكال هذا النظام، إلى جانب النظامين الرئاسي والبرلماني[1] ومع ذلك، يُعتبر هذا النظام من أقل الأنظمة السياسية انتشارًا، حيث لا يُطبق إلا في عدد محدود من الدول مثل سويسرا، وذلك بسبب الطبيعة الخاصة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظله، حيث تكون السلطة التنفيذية خاضعة تمامًا للسلطة التشريعية[2]
اولا: مفهوم نظام حكومة الجمعية النيابية : يقوم هذا النظام على تركيز اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد جمعية نيابية منتخبة من الشعب. يتميز هذا النظام بأن البرلمان هو صاحب السيادة العليا في الدولة، بينما تكون السلطة التنفيذية مجرد أداة تنفيذية تابعة له[3].
وتلجأ الدول إلى هذا النظام عادةً بعد تجارب مريرة مع استبداد السلطة التنفيذية، مما يدفعها إلى تقليص دورها وجعلها خاضعة للبرلمان[4]
ثانيا: الأسس الفلسفية لنظام حكومة الجمعية النيابية :يستند هذا النظام إلى مبدأ وحدة السيادة الشعبية وعدم قابليتها للتجزئة، كما نظر لها جان جاك روسو في كتابه "العقد الاجتماعي". يرى روسو أن الإرادة العامة لا يمكن تفويضها، وبالتالي يجب أن يمارس البرلمان جميع السلطات نيابة عن الشعب.[5]
كما يرفض روسو فكرة فصل السلطات التي نادى بها مونتسكيو، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية مجرد خادم للإرادة العامة وليس لها سيادة مستقلة[6]
ثالثا: الخصائص الأساسية لنظام حكومة الجمعية النيابية:
1. تركيز السلطة في البرلمان يكون البرلمان هو صاحب السيادة العليا في الدولة، ويمارس جميع السلطات التشريعية والتنفيذية[7]
2. خضوع الحكومة للبرلمان يتم تعيين أعضاء الحكومة وعزلهم من قبل البرلمان، وتكون قراراتهم خاضعة لرقابته[8]
3. مبدأ القيادة الجماعية تُمارس السلطة التنفيذية بشكل جماعي، دون وجود رئيس دولة ذي صلاحيات واسعة[9]
رابعا: العلاقة بين السلطات في ظل نظام حكومة الجمعية النيابية: لا يوجد فصل بين السلطات في هذا النظام، بل يتم دمجها في البرلمان، مما يجعله نظامًا لتركيز السلطات. ومع ذلك، تبقى هناك هيئتان منفصلتان تشريعية وتنفيذية من الناحية الشكلية[10]
خامسا: تطبيق نظام حكومة الجمعية النيابية في الاتحاد السويسري :تعد سويسرا النموذج الوحيد المستقر لهذا النظام، حيث تطبقه منذ أكثر من قرن وتتميز سويسرا بما يلي:
1. الهيكل السياسي: تتكون من ثلاثة مستويات (الاتحاد، الكانتونات، الكومونات)، مع وجود برلمان اتحادي (الجمعية الاتحادية) يتألف من مجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات
2. السلطة التنفيذية: يمثلها المجلس الاتحادي المكون من 7 أعضاء ينتخبهم البرلمان، ويتمتعون بصلاحيات محدودة.
3. السلطة القضائية: تتمثل في المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم المتخصصة، وتتمتع باستقلالية.
سادسا: تقدير نظام حكومة الجمعية النيابية
رغم ندرة تطبيقه، يُعتبر هذا النظام ديمقراطيًا في جوهره، لكنه قد يؤدي إلى استبداد البرلمانات إذا لم يكن هناك توازن. يعتبر النموذج السويسري ناجحًا بسبب الاستقرار السياسي والاجتماعي، بينما فشلت تجارب أخرى مثل فرنسا وتركيا بسبب الظروف الاستثنائية
الاستنتاجات يظل نظام حكومة الجمعية نظامًا ديمقراطيًا في النظرية، لكن تطبيقه العملي يتطلب شروطًا خاصة كتلك المتوفرة في سويسرا. وهو يعكس سيادة الشعب من خلال البرلمان، لكنه يحتاج إلى ضمانات لمنع الاستبداد.
1. نظام نادر التطبيق
o يُعد نظام حكومة الجمعية من أقل الأنظمة السياسية انتشارًا في العالم، حيث لا يُطبق بشكل دائم إلا في سويسرا.
o غالبًا ما يتم اللجوء إليه في فترات الأزمات أو التحولات السياسية (مثل فرنسا بعد الثورة، وتركيا بعد إلغاء الخلافة).
2. السيادة المطلقة للبرلمان
o يتميز النظام بتركيز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد البرلمان، مما يجعله صاحب الكلمة العليا في الدولة.
o الحكومة (السلطة التنفيذية) ضعيفة وتابعة للبرلمان، حيث يمكن تعيينها أو عزلتها بأغلبية برلمانية.
3. النجاح في سويسرا والفشل في دول أخرى
o نجح النظام في سويسرا بسبب:
§ الاستقرار السياسي والاجتماعي.
§ الحياد وعدم انخراطها في حروب خارجية.
§ الوعي السياسي العالي للمواطنين.
o فشل في دول أخرى (مثل فرنسا) بسبب:
§ تحوله إلى ديكتاتورية البرلمان (مثل عهد الإرهاب أثناء الثورة الفرنسية).
§ عدم وجود ضمانات كافية لحماية حقوق الأقليات.
أسئلة تقييمية حول البحث الثالث: النظام النيابي الجمعي (نظام حكومة الجمعية النيابية)
أسئلة موضوعية (اختيار من متعدد، صح أو خطأ)
ما هو الأساس الفلسفي لنظام حكومة الجمعية النيابية؟
أ) مبدأ الفصل بين السلطات
ب) مبدأ وحدة السيادة الشعبية وعدم قابليتها للتجزئة
ج) مبدأ سيادة القانون
د) مبدأ اللامركزية
أي من الدول التالية تطبق نظام حكومة الجمعية النيابية بشكل مستقر؟
أ) فرنسا
ب) سويسرا
ج) تركيا
د) الولايات المتحدة
ما هي إحدى الخصائص الرئيسية لنظام حكومة الجمعية؟
أ) استقلال السلطة التنفيذية عن التشريعية
ب) تركيز السلطات في يد البرلمان
ج) وجود رئيس دولة قوي
د) فصل تام بين السلطات
ما هو دور الحكومة في نظام حكومة الجمعية؟
أ) صنع القرارات السياسية بشكل مستقل
ب) تنفيذ سياسات البرلمان والخضوع لرقابته
ج) إصدار القوانين دون الرجوع إلى البرلمان
د) تعيين أعضاء البرلمان
ما هو السبب الرئيسي لنجاح نظام حكومة الجمعية في سويسرا؟
أ) وجود رئيس قوي
ب) الاستقرار السياسي والوعي المجتمعي العالي
ج) الاعتماد على النظام الرئاسي
د) ضعف السلطة التشريعية
اشرح الفرق بين نظام حكومة الجمعية والنظام البرلماني التقليدي من حيث العلاقة بين السلطات.
ما هي العوامل التي ساعدت سويسرا على تطبيق نظام حكومة الجمعية بنجاح؟
[1] Ardant, Philippe ; Institutions Politiques & Droit Constitutionnel (Paris, 14e édition 2002), p.338.
[2] جمال الجمل؛ الأنظمة السياسية المعاصرة (القاهرة: دار الشروق، 1977)، ص 194.
[3] عبد الحميد متولي؛ القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ص 255.
[4] Rousseau, Jean-Jacques; The Social Contract (London, 1923), Book II, Chapter I-IV.
[5] وحيد رأفت ود. وائل إبراهيم؛ القانون الدستوري (القاهرة، 1937)، ص 35
[6] Federal Constitution of the Swiss Confederation (1999), Articles 4, 70, 148.
[7] Swiss Federal Chancellery; *The Swiss Confederation: A Brief Guide* (2014), p.8.
[8] Church, Clive H.; The Politics and Government of Switzerland (2004), p.11.
[9] كمال الغايش؛ مبادئ القانون الدستوري (دمشق، 1984)، ص 302.
[10] إبراهيم عبد العزيز شحاته؛ النظم السياسية (الإسكندرية، 2000)، ص 430.
-
8- أنماط الاقتراع وتطبيقاتها في الجزائر
مقدمة
اولا: أساليب ممارسة العملية الانتخابية
1 الانتخاب المقيد والانتخاب العام
2 الانتخاب المباشر وغير المباشر
ثانيا: أنماط الاقتراع
1 الاقتراع الفردي
2 الاقتراع بالقائمة
3 الاقتراع النسبي والاقتراع بالأغلبية
3.تطبيقات نظام الاقتراع في الجزائر
مقدمة
يُعدُّ الاقتراع أحد الركائز الأساسية للنظم الديمقراطية، حيث يعكس إرادة الناخبين ويحدد شكل التمثيل السياسي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وتختلف أنماط الاقتراع من دولة إلى أخرى وفقًا للسياق التاريخي والسياسي والقانوني لكل بلد. وفي الجزائر، مثل غيرها من الدول، يشكل النظام الانتخابي أداة حاسمة في ترجمة الإرادة الشعبية إلى تمثيل سياسي فعّال، مما يجعله موضوعًا بالغ الأهمية في دراسة التطور الديمقراطي والحياة السياسية في البلاد.
اولا: أساليب ممارسة العملية الانتخابية
1 الانتخاب المقيد والانتخاب العام
يُقصد بالانتخاب العام ذلك النظام الذي يُمنح فيه حق التصويت لجميع المواطنين الذين بلغوا سنًا معينة، دون تمييز يُذكر سوى ما يقرّه القانون استثناءً. أما الانتخاب المقيد، فهو نظام يُقصر فيه حق التصويت على فئة معينة من المواطنين تتوافر فيهم شروط خاصة، كالمستوى التعليمي أو الضريبي أو الاجتماعي.
وقد شهد التاريخ تطورًا في الاتجاه نحو الانتخاب العام، خاصة بعد الحروب الكبرى التي دفعت نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية، تحت ضغط الحركات الاجتماعية ومطالب المساواة. ويُعتبر الانتخاب العام اليوم من مقومات الديمقراطية التمثيلية الحديثة، رغم استمرار بعض مظاهر القيد المرتبطة أحيانًا بالجنسية، أو الأهلية القانونية، أو السجل العدلي، وهو ما نجده في التشريعات الجزائرية كذلك، التي تشترط في الناخب أن يكون مسجلاً ضمن القوائم الانتخابية، وأن يتمتع بالأهلية المدنية والسياسية.[1]
2 الانتخاب المباشر وغير المباشر
الانتخاب المباشر هو الذي يمارس فيه الناخبون اختيار ممثليهم بأنفسهم دون وساطة، كما هو الشأن في انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجالس الشعبية. أما الانتخاب غير المباشر، فيُفوض فيه الناخبون اختيار هيئة وسيطة تتولى هي بدورها انتخاب الممثلين، كما هو الحال في انتخاب مجلس الأمة الجزائري .[2]
وقد أقرّ الدستور الجزائري بنمطين من الاقتراع: المباشر لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وغير المباشر بالنسبة لمجلس الأمة، حيث يتم اختيار أعضائه من قبل المجالس المحلية المنتخبة، وفقًا لما نصت عليه المادة 119 من دستور 2020 [3]
ثانيا: أنماط الاقتراع
1 الاقتراع الفردي الاقتراع الفردي هو النمط الذي يصوّت فيه الناخب لشخص واحد فقط، سواء في دورة واحدة أو دورتين. ويهدف هذا الأسلوب إلى تعزيز العلاقة المباشرة بين الناخب وممثله، وتكون الدوائر الانتخابية عادة صغيرة لضمان فعالية التمثيل الفردي.
يُعتمد هذا النمط في العديد من النظم ذات الطابع البرلماني، حيث يُعتبر مناسبًا للأنظمة التي تسعى لتعزيز المسؤولية السياسية للنواب تجاه ناخبيهم. غير أن من سلبياته أنه قد يكرّس النزعة المحلية على حساب البرامج الوطنية، كما أنه يُضعف فرص الأحزاب الصغيرة في الوصول إلى المقاعد البرلمانية[4].
في الجزائر، طُبّق الاقتراع الفردي في بعض الاستحقاقات المحلية، إلا أن النظام الغالب ظل قائمًا على القائمة النسبية، خاصة بعد التعديلات التي جاء بها قانون الانتخابات لسنة 2021، الذي أعاد تشكيل آلية الاقتراع على أساس القائمة المفتوحة.
2 الاقتراع بالقائمة: الاقتراع بالقائمة هو الأسلوب الذي يصوّت فيه الناخبون على قائمة حزبية أو مستقلة تتضمن مجموعة من المترشحين. وقد يكون اقتراعًا على قائمة مغلقة، يلتزم فيها الناخب بالترتيب المقدم من الحزب، أو قائمة مفتوحة، يختار فيها الناخب ترتيب المرشحين داخل القائمة.[5]
يسهم هذا النمط في ترسيخ التعددية الحزبية وتوزيع المقاعد بشكل يعكس الوزن الانتخابي الحقيقي لكل تيار سياسي. كما يعزز تمثيل النساء والشباب، خاصة إذا كان مشروطًا بميكانيزمات قانونية مثل المناصفة أو الكوطة.
وقد اعتمدت الجزائر هذا النمط في أغلب الانتخابات التشريعية والبلدية، خصوصًا بعد إصلاحات 2012، التي فرضت إلزامية تمثيل المرأة في القوائم [6]
ومع صدور الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، تم تبنّي نظام الاقتراع بالقائمة المفتوحة، ما أتاح للناخب حرية ترتيب المرشحين والتصويت التفضيلي، وهو ما يُعدّ تحوّلًا مهمًا في النظام الانتخابي الجزائري [7]
3 الاقتراع النسبي والاقتراع بالأغلبية: ينقسم الاقتراع من حيث طريقة احتساب النتائج إلى نمطين رئيسيين: الاقتراع بالأغلبية والاقتراع النسبي. في النظام بالأغلبية، يفوز المرشح أو القائمة التي تحصد الأغلبية المطلقة أو النسبية للأصوات. ويتميز هذا النظام بالوضوح وسهولة الفهم، إلا أنه قد يؤدي إلى إقصاء أقلية مهمة من التمثيل السياسي.[8]
أما النظام النسبي، فيسعى إلى تمثيل جميع التيارات وفقًا لحجمها الانتخابي الحقيقي، ويُطبّق غالبًا باستخدام طريقة التمثيل النسبي مع أحد أساليب توزيع المقاعد كطريقة سانت لوغو، أو القاسم الانتخابي. وقد اعتمدت الجزائر، في القانون العضوي للانتخابات الجديد (2021)، نظام التمثيل النسبي عبر القوائم المفتوحة، مع اعتماد العتبة الانتخابية 5% كشرط لدخول عملية توزيع المقاعد.[9]
ثالثا تطبيقات أنماط الاقتراع في الجزائر
1. تطور نظام الاقتراع في الجزائر
عرف النظام الانتخابي الجزائري تطورًا ملحوظًا منذ الاستقلال، فبعد أن كان قائمًا في بداياته على النمط الأحادي القائم على الحزب الواحد، اتجه بعد دستور 1989 نحو تبنّي التعددية السياسية والانتقال إلى أنماط اقتراع أكثر ديمقراطية.
ففي الانتخابات التشريعية لسنة 1991، تم تبني الاقتراع النسبي على أساس القائمة، وهو ما مكّن التيار الإسلامي من الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد في الدور الأول، قبل أن يتم توقيف المسار الانتخابي، ما فتح الباب أمام مراجعة عميقة للنظام الانتخابي لاحقًا[10].
2. تطبيق نظام التمثيل النسبي
منذ سنة 1997، اعتمدت الجزائر نظام الاقتراع النسبي على أساس القوائم المغلقة، وقد تم العمل بهذا النظام في عدة انتخابات (تشريعية، بلدية، ولائية). ويُعد هذا النظام ملائمًا لطبيعة المشهد السياسي الجزائري المتعدد، حيث يسمح بتمثيل أوسع للأحزاب السياسية.
غير أن هذا النظام شابه العديد من النقائص، من بينها هيمنة رؤساء القوائم على المقاعد، وغياب الشفافية في الترتيب الداخلي للمرشحين، ما دفع إلى المطالبة بإصلاحات عميقة لنمط الاقتراع المعتمد.[11]
3. التحول إلى نظام القائمة المفتوحة
في ظل الحراك الشعبي الذي انطلق سنة 2019، تمّت مراجعة جذرية للقانون الانتخابي، حيث تم تبنّي نظام القائمة المفتوحة لأول مرة في الانتخابات التشريعية لـ12 جوان 2021. ويقوم هذا النظام على إعطاء الناخب حرية ترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة، مع احتساب الأصوات التفضيلية لكل مرشح.
وقد لاقى هذا التحول ترحيبًا واسعًا، باعتباره يُقلص من هيمنة رؤساء القوائم، ويمنح الناخب سلطة أكبر في اختيار ممثليه، كما يُشجّع على التنافس داخل القوائم نفسها.[12]
غير أن هذا النظام الجديد لا يزال في طور التجريب، ويحتاج إلى ضبط أكبر من حيث التكوين الانتخابي، وتبسيط طريقة احتساب الأصوات، التي كانت معقدة بعض الشيء خلال أول تجربة.[13]
تقييم نظام الاقتراع الجديد في الجزائر
رغم الخطوة الإيجابية نحو القائمة المفتوحة، إلا أن عدة تقارير أكاديمية وملاحظات ميدانية أشارت إلى بعض الإشكالات، من بينها ضعف نسبة المشاركة، خاصة في المدن الكبرى، وغياب ثقافة الانتخاب التفضيلي لدى فئات واسعة من الناخبين [14]
كما أن عدداً من الأحزاب السياسية اشتكت من صعوبة إعداد القوائم وفق النظام الجديد، ومن ضعف التأطير القانوني لبعض جوانبه.
ورغم ذلك، فإن هذه التجربة تُعد بداية مهمة نحو إعادة تشكيل المشهد السياسي الجزائري على أسس جديدة أكثر شفافية، تكرّس للمساءلة السياسية والفعل الانتخابي الواعي [15]
الاستنتاجات
شهد النظام الانتخابي الجزائري تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، حيث انتقل من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية السياسية، ثم إلى نظام أكثر ديمقراطية يعتمد على التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة. وقد جاء هذا التطور استجابة للمتغيرات السياسية والاجتماعية، وخاصة بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد.
أبرز النتائج التي يمكن استخلاصها:
1. التطور الإيجابي للنظام الانتخابي:
§ تحسن تدريجي في شفافية العملية الانتخابية
§ زيادة فرص التمثيل السياسي للأحزاب والتيارات المختلفة
§ تعزيز مشاركة المرأة والشباب عبر آليات الكوتا
2. التحديات القائمة:
§ ضعف الإقبال الانتخابي وخاصة في المناطق الحضرية
§ صعوبة فهم الناخبين للأنظمة الانتخابية المعقدة
§ الحاجة لتعزيز الثقافة الانتخابية لدى المواطنين
3. متطلبات التطوير المستقبلي:
§ تبسيط الإجراءات الانتخابية
§ تعزيز برامج التوعية الانتخابية
§ تطوير آليات الرقابة على الانتخابات
§ مراجعة نظام العتبة الانتخابية لتحقيق تمثيل أفضل
الأسئلة التقييمية
1. أي من الأنظمة الانتخابية التالية اعتمدته الجزائر في انتخابات 2021؟
أ) الاقتراع الفردي
ب) التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة
ج) التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة
د) نظام الكوتا النسائية2. ما هي العتبة الانتخابية المطبقة في الانتخابات الجزائرية حالياً؟
أ) 3%
ب) 5%
ج) 7%
د) 10%3. أي من المبادئ التالية يميز الانتخاب العام عن الانتخاب المقيد؟
أ) اشتراط مؤهل تعليمي معين
ب) تقييد حق التصويت بالذكور فقط
ج) منح الحق الانتخابي لجميع المواطنين البالغين
د) اشتراط دفع ضرائب معينةأسئلة مقالية قصيرة
1. ما الفرق بين الانتخاب المباشر وغير المباشر مع ذكر مثال على كل منهما من النظام الجزائري؟
2. كيف يسهم نظام القوائم المفتوحة في تعزيز الديمقراطية التشاركية؟
3. ما هي أهم التحديات التي تواجه تطبيق النظام الانتخابي الحالي في الجزائر؟
أسئلة تحليلية ونقدية
1. قارن بين نظامي الاقتراع الفردي والاقتراع بالقائمة من حيث المزايا والعيوب في السياق الجزائري.
2. ناقش مدى نجاح التعديلات الانتخابية الأخيرة في تحقيق المطالب الشعبية للحراك.
3. هل تعتقد أن النظام الانتخابي الحالي في الجزائر قادر على تمثيل كافة التيارات السياسية بشكل عادل؟ علل إجابتك.
[1] عبد الفتاح بيومي حجازي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009، ص 136.
[2] صالح مقلد، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، بيروت، 2014، ص 192.
[3] دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل 2020، المادة 119، الجريدة الرسمية العدد 82، ص 11.
[4] عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المعارف، القاهرة، ط3، 2015، ص 212.
[5] حسن نافعة، التمثيل السياسي وأنظمة الاقتراع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007، ص 88.
[6] خديجة بن قانة، "نظام الكوتا في الجزائر: الآليات والتحديات"، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 10، 2016، ص 142.
[7] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتعلق بنظام الانتخابات، المواد 190–194.
[8] Maurice Duverger, Les Partis Politiques, PUF, Paris, 1976, p. 103.
[9] عبد الرحمان شايب، "إصلاح المنظومة الانتخابية في الجزائر بين النص والتطبيق"، مجلة القانون والمجتمع، جامعة وهران، عدد خاص، 2022، ص 77.
[10] عبد العالي رزاقي، الانتخابات في الجزائر: بين التعددية السياسية والشرعية الشعبية، دار الهدى، الجزائر، 2011، ص 73.
[11] عبد الحق بن خدة، "النظام الانتخابي في الجزائر بين النص والتطبيق"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 15، 2015، ص 99.
[12] المركز الوطني للدراسات والتحليل السياسي، "تقييم الانتخابات التشريعية 2021"، تقرير داخلي، الجزائر، 2021، ص 27.
[13] إسماعيل معراف، "نظام القائمة المفتوحة في الجزائر: قراءة في أول تجربة"، مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة باتنة، العدد 9، 2022، ص 51.
[14] جريدة الخبر، "ضعف المشاركة في الانتخابات: الأسباب والدلالات"، عدد 12345، جوان 2021، ص 4.
[15] نذير قسوم، "إصلاحات النظام الانتخابي الجزائري: رؤية استشرافية"، ملتقى وطني، جامعة الجزائر 1، مارس 2022، ص 12.
-
9.الأحزاب السياسية وطرق اعتمادها
1. مقدمة
2. المبحث الأول : مفهوم الحزب السياسي وأهميته
المطلب الأول: تعريف الحزب السياسي
المطلب الثاني: وظائف الأحزاب السياسية
3. المبحث الثاني : نشأة الأحزاب السياسية وتطورها
المطلب الأول: الخلفية التاريخية لنشأة الأحزاب
المطلب الثاني: تطور الأحزاب في النظم السياسية المختلفة
4. المبحث الثالث : طرق اعتماد الأحزاب وتنظيمها القانوني
المطلب الأول: شروط تأسيس الحزب السياسي
المطلب الثاني: الإجراءات القانونية للاعتماد والتسجيل
5. خاتمة
6. قائمة المراجع
مقدمة
تعد الأحزاب السياسية أحد الأعمدة الأساسية في النظام الديمقراطي، حيث تساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم، كما تشكل وسيلة للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات. ويرتبط وجود الأحزاب بقيم التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة، ما يجعل مسألة اعتمادها وتنظيمها محل اهتمام دائم من قبل التشريعات الوطنية والمنظمات الدولية. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم الأحزاب السياسية، تطورها التاريخي، وطرق اعتمادها من الناحية القانونية والتنظيمية.
المبحث الأول: مفهوم الحزب السياسي وأهميته
المطلب الأول: تعريف الحزب السياسي
يُعرَّف الحزب السياسي بأنه "تنظيم دائم يسعى للوصول إلى السلطة أو التأثير فيها، من خلال برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يعبر عن فئة أو طبقة أو مذهب معين في المجتمع"[1]. ويُعتبر الحزب وسيلة لتجميع المصالح الاجتماعية وتوجيهها ضمن أطر قانونية مشروعة.
المطلب الثاني: وظائف الأحزاب السياسية
تلعب الأحزاب السياسية أدوارًا متعددة، أهمها: تأطير المواطنين، والمشاركة في الحياة السياسية، وتقديم البرامج الانتخابية، وتكوين النخب السياسية، فضلاً عن مراقبة السلطة الحاكمة[2].
المبحث الثاني: نشأة الأحزاب السياسية وتطورها
المطلب الأول: الخلفية التاريخية لنشأة الأحزاب
ظهرت الأحزاب السياسية لأول مرة في المجتمعات الأوروبية خلال القرن التاسع عشر، كنتيجة مباشرة لتحول الأنظمة من سلطات مطلقة إلى نظم ديمقراطية تمثيلية. وتُعد الثورة الفرنسية من أبرز المحطات التي مهّدت لتبلور الأحزاب بمفهومها الحديث[3].
المطلب الثاني: تطور الأحزاب في النظم السياسية المختلفة
اختلف مسار تطور الأحزاب باختلاف السياقات السياسية. ففي الأنظمة الليبرالية، تطورت الأحزاب وفق مبدأ التعددية، بينما ارتبطت في الأنظمة الشمولية بالحزب الواحد المسيطر على الدولة.[4]
المبحث الثالث: طرق اعتماد الأحزاب وتنظيمها القانوني
المطلب الأول: شروط تأسيس الحزب السياسي
تتباين شروط تأسيس الأحزاب السياسية من بلد إلى آخر، لكنها غالبًا ما تشمل: ضرورة توفر عدد أدنى من المؤسسين، وجود برنامج سياسي واضح، وامتلاك مقر قانوني.[5]
المطلب الثاني: الإجراءات القانونية للاعتماد والتسجيل
يتم اعتماد الأحزاب من خلال تقديم ملف قانوني إلى جهة رسمية (عادة وزارة الداخلية أو هيئة الانتخابات)، يشمل الوثائق المؤسسة للحزب، والبيان التأسيسي، وقائمة المؤسسين، وبرنامجه السياسي. ويتم البت في الملف خلال فترة زمنية تحددها القوانين المحلية، وغالبًا ما تمنح شهادة اعتماد للحزب بعد استيفاء الشروط (6).
الخاتمة
تشكل الأحزاب السياسية جزءًا لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية، فهي أداة للتمثيل والتأطير والمشاركة السياسية. غير أن نجاح دورها يظل مرهونًا بمدى التزامها بالقانون، وتوفر بيئة سياسية تسمح بالتعددية، وتحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير. ولعل تنظيم عملية اعتماد الأحزاب بشكل شفاف وعادل يشكل خطوة أساسية لضمان نزاهة العملية السياسية ككل.
الاستنتاجات
يُعد موضوع الأحزاب السياسية وطرق اعتمادها من الموضوعات الحيوية في الدراسات السياسية والقانونية، حيث تشكل الأحزاب السياسية قنوات مؤسسية لتنظيم المشاركة السياسية وتجسيد مبدأ التعددية الديمقراطية. وقد تناول هذا البحث مفهوم الأحزاب السياسية، وتطورها التاريخي، ووظائفها، وآليات اعتمادها قانونيًا، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها في البيئات السياسية المختلفة.
1. الأحزاب السياسية كأداة للتمثيل الديمقراطي:
o تؤدي الأحزاب دورًا محوريًا في تجميع المصالح وصياغة المطالب المجتمعية، مما يجعلها وسيطًا بين الدولة والمواطنين.
o تعتمد ديمقراطية النظام السياسي على مدى تعددية الأحزاب وشفافيتها واستقلاليتها.
2. تطور الأحزاب من النخبوية إلى الجماهيرية:
o تحولت الأحزاب من تجمعات نخبوية إلى منظمات جماهيرية مع توسع حق الانتخاب وزيادة المشاركة السياسية.
o في العصر الحديث، تواجه الأحزاب أزمة هوية بسبب تراجع الانتماء الحزبي وصعود الحركات الاجتماعية غير الحزبية.
3. اختلاف النظم القانونية لاعتماد الأحزاب:
o تتباين شروط تأسيس الأحزاب بين الدول، فبعضها يعتمد نظام الإخطار (كفرنسا)، بينما يشترط آخرون موافقة مسبقة (كمصر).
o تشمل الشروط المشتركة الحد الأدنى للأعضاء، وعدم التعارض مع الدستور، والشفافية المالية.
4. التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية:
o تحديات داخلية: كالانقسامات وضعف التمويل وعدم الديمقراطية الداخلية.
o تحديات خارجية: كالقيود القانونية المفروضة من الأنظمة السلطوية وهيمنة الأحزاب الحاكمة.
أسئلة تقييمية
1. ما مدى فعالية الأحزاب السياسية في تحقيق التمثيل الحقيقي لمختلف فئات المجتمع؟
2. هل تؤدي القيود القانونية المفروضة على تأسيس الأحزاب إلى تعزيز الاستقرار السياسي أم إلى تقييد التعددية؟
3. كيف يمكن للأحزاب السياسية تجاوز أزمتها الحالية في ظل تراجع الثقة بها وصعود البدائل غير الحزبية؟
4. ما هي الضمانات القانونية اللازمة لضمان استقلالية الأحزاب وحياديتها؟
5. إلى أي درجة تؤثر الأنظمة الانتخابية على تطور الحياة الحزبية في الدول الديمقراطية؟
قائمة المراجع:
[1] بطرس غالي، موسوعة العلوم السياسية، القاهرة: دار الفكر العربي، 2005، ص 112.
[2] محمد الشاذلي، النظم السياسية المقارنة، بيروت: دار النهضة العربية، 2011، ص 89.
[3] Maurice Duverger, Les Partis Politiques, Paris: Seuil, 1951, p. 24.
[4] جلال عبد العال، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007، ص 45
[5] فريد زهران، التحول الديمقراطي في العالم العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010، ص 73.
-
النظام السياسي الجزائري بين الأحادية الحزبية والتعددية
1. مقدمة
2. المبحث الأول : النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية الحزبية (1962–1989)
المطلب الأول: السياق التأسيسي للدولة المستقلة وهيمنة الشرعية الثورية
المطلب الثاني: البناء الدستوري والمؤسساتي في ظل الحزب الواحد
المطلب الثالث: الإشكالات القانونية المرتبطة بمبدأ الفصل بين السلطات
3. المبحث الثاني: النظام السياسي الجزائري في ظل التعددية الحزبية (1989–2020)
المطلب الأول: التحول الدستوري نحو التعددية السياسية
المطلب الثاني: توازن السلطات في النص والممارسة
المطلب الثالث: دور المؤسسة العسكرية في ضبط المشهد السياسي
4. المبحث الثالث : التعديل الدستوري 2020 وإعادة هندسة النظام السياسي
المطلب الأول: تحليل قانوني لمضامين دستور 2020
المطلب الثاني: التحديات القانونية في أفق بناء دولة الحق والقانون
5. الاستنتاجات
6. قائمة المراجع
مقدمة يمثل النظام السياسي الجزائري نموذجًا خاصًا في العالم العربي والإفريقي، فهو نِتاجُ مسارٍ ثوري طويل أفرز مؤسسات سياسية ذات طابع مركزي أحادي، ثم عرف في نهاية الثمانينيات تحولا بارزا باتجاه التعددية الحزبية. غير أن هذا التحول ظل حبيس البنية السلطوية التي لم تُمكِّن من ترسيخ ديمقراطية فعلية قائمة على مبدأ التداول، الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء.
الدراسة التالية تتناول هذا النظام في بعده القانوني والدستوري، بالتحليل والمقارنة بين مرحلتين مفصليتين: مرحلة الأحادية الحزبية (1962–1989) ومرحلة التعددية (1989–الآن)، مع التركيز على الأبعاد القانونية لممارسات السلطة وتوازنها بين المؤسسات، في ظل آخر تعديل دستوري عرفته البلاد سنة 2020.
المبحث الأول: النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية الحزبية (1962–1989)
المطلب الأول: السياق التأسيسي وهيمنة الشرعية الثورية
تأسس النظام السياسي الجزائري عقب الاستقلال على شرعية وحيدة تُسمى "الشرعية الثورية"، حيث مُنحت جبهة التحرير الوطني (FLN) موقع الحزب القائد الذي لا منافس له، بحكم قيادته للكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. وقد تُرجمت هذه الهيمنة من خلال النصوص القانونية والدستورية الأولى، وأُقصيت بقية القوى السياسية والاجتماعية المعارضة أو المستقلة[1].
المطلب الثاني: البناء الدستوري والمؤسساتي في ظل الحزب الواحد
أُقرّ أول دستور للبلاد في سبتمبر 1963، ثم تم تعليقه سنة 1965 بعد الانقلاب الذي قاده هواري بومدين، ليدخل البلد في مرحلة "الشرعية الثورية بالأمر الواقع"، إلى غاية صدور دستور 1976 الذي نص صراحة على الدور المركزي لجبهة التحرير الوطني في المادة 4 منه، باعتبارها "الطليعة القائدة للدولة والمجتمع[2]
وقد منح هذا الدستور رئيس الجمهورية سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية شبه مطلقة، كحق اقتراح القوانين، تعيين القضاة، رئاسة مجلس الوزراء، والقيادة العليا للقوات المسلحة [3]
المطلب الثالث: الإشكالات القانونية المرتبطة بمبدأ الفصل بين السلطات
يُلاحظ أن دساتير هذه المرحلة لم تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بالمفهوم الدستوري الكلاسيكي، بل تم تذويب البرلمان في وظائف استشارية أو تشريعية خاضعة للسلطة التنفيذية. كما كان القضاء يُعيَّن ويُعزل بمرسوم رئاسي، ما يفقده عنصر الاستقلالية[4].
والنتيجة كانت نظامًا يقوم على مركزية السلطة السياسية في يد رئيس الجمهورية، بغطاء شرعي حزبي ثوري.
المبحث الثاني: النظام السياسي في ظل التعددية الحزبية (1989–2020)
المطلب الأول: التحول الدستوري نحو التعددية السياسية
شهدت الجزائر تحولا دستوريًا نوعيًا بعد أحداث أكتوبر 1988 التي فجّرت موجة احتجاجات اجتماعية، أجبرت النظام على تعديل دستوري جذري سنة 1989، تم بموجبه إلغاء المادة 4 من دستور 1976، وفتح المجال أمام حرية تكوين الأحزاب (المادة 40)، والاعتراف بتعدد الرؤى السياسية، رغم اشتراط "عدم المساس بالثوابت الوطنية".[5]
المطلب الثاني: توازن السلطات في النص والممارسة
رغم أن دستور 1989 وما تلاه من تعديلات (1996، 2008، 2016) نص على مبدأ الفصل بين السلطات، غير أن الواقع السياسي أثبت هشاشة هذا المبدأ، إذ بقيت مؤسسة الرئاسة مهيمنة، وتم تكريس آليات تقييدية مثل سلطة حل البرلمان، تعديل الدستور بمراسيم، تعيين القضاة، ورئاسة مجلس القضاة الأعلى [6]
أما البرلمان، فغالبًا ما كان مجرد هيئة لتصديق سياسات الحكومة، وهو ما يتنافى مع مبدأ الرقابة البرلمانية، كما أن التعددية السياسية تم احتواؤها من خلال التحكم في شروط اعتماد الأحزاب والتمويل العمومي لها[7].
المطلب الثالث: دور المؤسسة العسكرية في ضبط المشهد السياسي
رغم أن الدساتير لم تُشر صراحة إلى دور الجيش في الحياة السياسية، إلا أن المؤسسة العسكرية ظلت اللاعب الحاسم في إدارة المرحلة الانتقالية بعد وقف المسار الانتخابي في 1992، وفي الإطاحة برؤساء أو دعم آخرين، مثل بوتفليقة في 1999 ثم الاستقالة سنة 2019، ما يُثير إشكالية العلاقة بين السلطة المدنية والعسكرية في ظل النظام الدستوري[8].
المبحث الثالث: التعديل الدستوري 2020 وإعادة هندسة النظام السياسي
المطلب الأول: تحليل قانوني لمضامين دستور 2020
في أعقاب الحراك الشعبي، أُقر دستور جديد سنة 2020 تضمن مستجدات من بينها:
تقليص عهدات الرئيس إلى عهدتين فقط (المادة 88)،
استحداث المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري (المادة 224)،
إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان،
التنصيص على مشاركة الجيش في الخارج بشروط برلمانية (المادة 91/7) لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية.
لكن الملاحظة الأهم أن الدستور لم يحدّ من الصلاحيات الجوهرية للرئيس، بل أبقى على مركزية السلطة التنفيذية، بما في ذلك تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ورئاسة مجلس الوزراء.[9]
المطلب الثاني: التحديات القانونية لبناء دولة الحق والقانون
تتمثل أبرز التحديات فيما يلي:
ضعف استقلال القضاء رغم التنصيص عليه دستوريا،
غياب قضاء دستوري فعّال مستقل،
هشاشة الأحزاب السياسية وخضوعها لشروط اعتماد صارمة،
غياب إطار قانوني فعال لمكافحة الفساد السياسي والمؤسساتي،
ضعف ضمانات الحريات الفردية والجماعية في الممارسة.
الاستنتاجات
يمثل النظام السياسي الجزائري نموذجًا ديناميكيًا تطور عبر مراحل متباينة، من الأحادية الحزبية القائمة على الشرعية الثورية إلى التعددية الشكلية التي لم تُفضِ إلى ديمقراطية حقيقية. ففي المرحلة الأولى (1962–1989)، هيمنت جبهة التحرير الوطني على المشهد السياسي تحت مظلة دستور يكرس سلطة مطلقة للرئاسة، ويُهمش مبدأ الفصل بين السلطات. أما بعد 1989، فقد فُتح الباب أمام التعددية الحزبية، لكنها ظلت مقيدة بآليات قانونية وسياسية حفظت هيمنة السلطة التنفيذية، خاصة في ظل الدور غير المعلن للمؤسسة العسكرية.
التعديل الدستوري لعام 2020 جاء استجابةً للحراك الشعبي، لكنه لم يُحدث قطيعة جذرية مع المركزية الرئاسية، بل أبقى على صلاحيات واسعة للرئيس، بينما زاد من تعقيد الإطار الدستوري دون ضمانات فعلية لاستقلالية القضاء أو توازن السلطات.
1. الشرعية الثورية كإطار سلطوي: مثلت الهيمنة التاريخية لجبهة التحرير الوطني أساسًا لشرعية أحادية، جعلت الديمقراطية التمثيلية شكلية حتى بعد التعددية.
2. التعددية المقيدة: رغم الإصلاحات الدستورية منذ 1989، بقيت الآليات القانونية (مثل شروط تأسيس الأحزاب، صلاحيات الرئاسة) تُفرغ التعددية من مضمونها.
3. دور الجيش الخفي: ظلت المؤسسة العسكرية لاعبًا مركزيًا في صناعة القرار، مما يُناقض مبدأ سيطرة المدنيين على الدولة في النصوص الدستورية.
4. دستور 2020: إصلاح غير جذري: رغم تقليص العهدات الرئاسية واستحداث محكمة دستورية، بقي النظام مركزيًا، مع ضعف ضمانات استقلال القضاء والمؤسسات.
أسئلة تقييمية
1. هل يمكن اعتبار التعددية الحزبية في الجزائر منذ 1989 تعددية حقيقية أم شكلية في ظل هيمنة السلطة التنفيذية؟
2. إلى أي درجة نجح دستور 2020 في معالجة إشكالية الفصل بين السلطات، خاصة مع استمرار تعيين الرئيس لأعضاء المحكمة الدستورية؟
3. كيف يُمكن تفسير التناقض بين النص الدستوري الذي يُكرس ديمقراطية تعددية، والممارسة السياسية التي تُبقي على مركزية القرار؟
4. ما مدى تأثير العامل العسكري في الخيارات الدستورية الجزائرية، وهل يمكن الحديث عن "ديمقراطية تحت الوصاية"؟
5. هل تُشكل التعديلات الدستورية المتكررة (1996، 2008، 2016، 2020) آليةً لتطوير النظام السياسي أم أداةً لترسيخ الوضع القائم؟
قائمة المراجع:
[1] دستور الجزائر 1976، المادة 4.
[2] محمد العربي آيت خويا، النظام السياسي الجزائري، دار المعرفة، 2018، ص 45.
[3] دستور الجزائر 1976، المواد 112–120
[4] رابح لونيسي، السلطة والتعددية في الجزائر، دار القصبة، 2009، ص 63.
[5] دستور الجزائر 1989، المواد 39–40.
[6] دستور الجزائر 2008، المادة 77
[7] عبد الحميد مزيان، الديمقراطية في الجزائر بين النص والتطبيق، دار الحكمة، 2017، ص 78.
[8] Hugh Roberts, The Battlefield Algeria 1988–2002, Verso, 2003, p. 112
[9] دستور الجزائر 2020، المواد من 88 إلى 224.